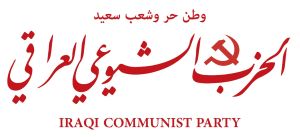مقدمة
أزعم أن موضوع البعد الطبقي في صناعة التأمين لم يشغل فكر ممارسي التأمين في العراق، فمعظمهم مستغرقون في الجوانب الفنية والقانونية للتأمين وقلما ينظر إلى التأمين كمؤسسة تعمل في إطار اقتصادي-اجتماعي وبموجب ضوابط قانونية يراد منها حماية المؤمن لهم والمنتفعين من حماية التأمين كما تجسدها وثائق التأمين المختلفة. وحتى علماء الاجتماع والاقتصاديين لم يهتموا بالمقاربة الطبقية لمؤسسة التأمين.
الفقرات التالية لا ترقى إلى ورقة بحثية بل هي مجرد خطوط عامة يمكن الاستفادة منها في دراسة موسعة وموثقة. وهي لذلك محاولة للاقتراب من الموضوع بأمل أن ينهض الغير لإشباعه بالدرس والتحليل.
كيف يتجلى البعد الطبقي في صناعة التأمين؟
يمكن اختزال الجواب في تفاوت الوصول إلى الخدمات التأمينية، وتفاوت الحماية الاجتماعية بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. وقد جاءت التطورات الحديثة المرتبطة بالتحول الرقمي والتسعير الفردي لتزيد كم هذا التفاوت وتشكل تهديدًا مبطنًا لمبدأ التضامن الذي ينتظم مؤسسة التأمين. سنحاول فيما يلي إلقاء بعض الضوء على هذه الظواهر.
إن مبدأ التضامن التأميني، المتوارث من ممارسات وأعراف مغرقة في القدم، يقوم على أساس فكرة بسيطة تقضي بأن يقوم جميع المؤمن لهم بدفع أقساط متقاربة وعند تحقق الضرر المؤمن منه يستفيد المتضررين من المؤمن لهم من هذه الأقساط لتعويضهم.
هذه السياسة التسعيرية خضعت لتحويرات رافقت تطور صناعة التأمين وتطور أدوات التعامل مع الأخطار التأمينية ومنها الإحصائيات المتراكمة والمناهج الاكتوارية (وخاصة في فرع التأمين على الحياة) تُمكّن شركات التأمين من التفريق بين المؤمن لهم إلى فئات محددة بالاعتماد على مقاييس metrics جديدة. وكان للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وكلاهما يتطوران بسرعة كبيرة، الدور الأكبر في السياسة الاكتتابية إذ صار بالإمكان تطبيق التسعير الدقيق حسب مواصفات الملف الشخصي profile لطالب التأمين. يعني هذا أنه صار بالإمكان تمييز ملفات طالبي التأمين المرتقبين من الفئات الفقيرة عن غيرهم من الفئات الاجتماعية. ومن هنا ينشأ التمييز الطبقي غير المباشر بين هذه الفئات، فالفقراء يصنفون كأصحاب المخاطر العالية، وهو ما يدفع بشركات التأمين إلى تطبيق أسعار أعلى أو شروط أقسى عليهم وحتى استبعادهم من حماية التأمين.
من المفيد التأكيد على أن استخدام الخوارزميات لتحديد المخاطر الفردية يهدد مبدأ التضامن/التكافل الاجتماعي، ويحول التأمين إلى خدمة انتقائية لا جماعية، لأنه يستبعد الطبقات الفقيرة من دائرة الحماية التأمينية، ما لم تتخذ التدابير المناسبة ومنها: الدعم التبادلي بين الفئات التأمينية cross subsidisation أو الإعانة المتبادلة داخل المحفظة التأمينية، كأن أن تقوم شركة التأمين بتحميل بعض الفئات من المؤمن عليهم أقساطًا أعلى من المخاطر التي يمثلونها فعليًا، من أجل تغطية خسائر فئات أخرى أكثر عرضة للمخاطر أو أقل قدرة على دفع أقساط التأمين.
لقد نشأ التأمين، في أشكاله الأولية في المجتمعات القديمة، كمؤسسة تضامنية وليس كأداة مالية صرفة. لكنه مع مرور الوقت والتغييرات البنيوية في الحياة الاقتصادية، وخاصة مع نشوء الرأسمالية، صار التأمين أداة تجارية مهمة تستهدف الربح أساسًا.
البعد الطبقي في التطبيق: الولايات المتحدة الأمريكية
تقدم الولايات المتحدة الأمريكية مثالاً تاريخيًا على التفاوت في تأمين الطبقات الفقيرة من خلال رسم خط أحمر redlining على خرائط المدن لتحديد الأحياء السكنية التي تعتبر مناطق ذات خطورة عالية (حيث تكون فرص تحقق الخطر المؤمن منه أعلى من المعدل)، وبالتالي في حال التأمين عليها فإنها تخضع لأسعار تأمين أعلى وتضييق في شروط التغطية التأمينية، أو قد تلجأ شركة التأمين إلى رفض قبول طلب التأمين.[i] وكانت مثل هذه المناطق تضم الدور السكنية للسود والأقليات العرقية الفقيرة.
كان من نتائج هذا التحديد الجغرافي، العنصري والطبقي، الذي لم يقتصر على التأمين بل البنوك والقروض وغيرها من الخدمات المالية، ضعف البنية التحتية لعقود طويلة وكذلك الخدمات العامة بما فيها التعليم. لم يتحسن الوضع إلا مع نهوض حركة الحقوق المدنية وتعاظمها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. ومع هذا فإن اللجوء القانوني إلى تقسيم المناطق حسب الاستخدام (سكنية، تجارية، صناعية ...) zoning صار غطاءً لتكريس التفاوت والتمييز الاقتصادي والاجتماعي. على سبيل المثل، منع بناء مساكن منخفضة التكلفة أو منع بناء شقق متعددة الأسر multi-family apartments في مناطق الأغنياء، وهو ما يعيد إنتاج نتائج الخرائط التي كانت محددة بخطوط حمراء.
الفجوة الطبقية والشمول التأميني
وهكذا فإن هناك فجوة ذو بُعد طبقي في الوصول إلى شراء الحماية التأمينية في أسواق التأمين. يضاف إلى ذلك أن ارتفاع أسعار التأمين يؤدي إلى استبعاد أصحاب الدخول الواطئة من التأمين على مساكنهم أو التأمين على حياتهم أو التأمين الصحي. يعني هذا أن الطلب الفعّال (المدعم بالقدرة المالية على تسديد أقساط التأمين) على التأمين يتركز في الطبقات الوسطى والعليا. وهذا الواقع التأميني ينطبق على الدول النامية. وقد شهدت العقود القليلة الماضية تطوير نمط جديد من الحماية التأمينية تحت اسم التأمين المتناهي الصغر microinsurance خصيصًا للطبقات الفقيرة في الريف (التأمين الزراعي كمثال) كمحاولة لتوسيع دائرة الشمول التأميني.
فجوة التأمين تجد حضورًا لها أيضًا بسبب دخول الرقمنة وتعاظمها في العملية التأمينية إذ أن من لا يملك الأدوات الرقمية والمهارات التقنية المرتبطة بها يصبح خارج العملية. أي أننا أمام حالة جديدة من الفقر الرقمي بعد أن كان الفقر الأبجدي والثقافي هو الذي يحول دون توافر حماية التأمين. إن خطر التمييز الطبقي الناتج من الرقمنة سيظل قائمًا إذ أن من لا يملك هاتفًا ذكيًا أو حسابًا مصرفيًا سيُقصى من الخدمات الرقمية، وهو ما يعيد إنتاج التفاوت الطبقي.
البُعد الطبقي في صناعة التأمين العراقي
تُعد صناعة التأمين التجارية واحدة من أدوات الحماية الاجتماعية في المجتمعات الحديثة إضافة إلى ما تقدمه الدولة من خدمات ارتبطت بمفاهيم دولة الرفاه الحديثة. والفرق بين التأمين التجاري والتأمين الاجتماعي بأشكاله المختلفة التي تقدمه الدولة هو أن الأولى تُموّل من أقساط المؤمن لهم والثانية تمول من خلال الضرائب التي تجبيها الدولة.
يتخذ البعد الطبقي في صناعة التأمين في السياق العراقي أبعادًا مركّبة ترتبط بتاريخ الدولة الحديثة وضعف سياسات الحماية الاجتماعية، وانعدام الثقة بالمؤسسات، إضافة إلى التفاوت الاقتصادي الحاد بين الطبقات الاجتماعية.
أزعم أن صناعة التأمين التجاري في السياق العراقي لم تنجح في تجاوز طابعها النخبوي، وأنها ساهمت في ترسيخ البُعد الطبقي عبر استبعاد الفئات الفقيرة من مظلة الحماية. إن استعراضًا سريعًا لبدايات هذه الصناعة في العراق في عشرينيات القرن الماضي، تشير إلى أنها نشأت ضمن سياق اقتصادي وتجاري نخبوّي لتلبية احتياجات التجارة والاستيراد،[ii] وارتبطت، أساسًا، بالطبقة التجارية اليهودية في بغداد والبصرة التي لم تكن تدير شركات للتأمين بل وكالات تأمين لشركات تأمين أجنبية.[iii] أي أنها لم تكن أصلاً معنية بتوفر حماية التأمين للطبقات الفقيرة في المدن أو في الريف.
إن تطور النشاط التأميني فيما بعد لم يتجاوز هذا التأسيس الطبقي النخبوي، حيث بقي التأمين حكرًا على من يملك رأس المال أو يرتبط بشبكات تجارية دولية. ولم يغير تأسيس أول شركة تأمين عراقية تجارية سنة 1946 (برأسمال أجنبي 60% ورأسمال عراقي 40%) وأول شركة تأمين حكومية (شركة التأمين الوطنية، 1950) وبعدها شركات تأمين خاصة (خمسينيات القرن الماضي) من طبيعة الحماية التأمينية الطبقية التي كانت تعرضها للبيع. وحتى تأميم صناعة التأمين سنة 1964 لم يساهم في تحول التأمين إلى أداة للعدالة الاجتماعية، فهي لم تنجح في تطوير التأمين الصحي أو الزراعي أو الحماية التأمينية للطبقات الفقيرة إلا بالحدود الدنيا وحتى الوقت الحاضر. وقل مثل ذلك بالنسبة للتأمين الاجتماعي. وأزعم لذلك أن الدولة العراقية لم تنجح في تحويل التأمين إلى أداة للعدالة الاجتماعية التي ظلت هامشية وانعكست بآثارها على الطبقة العاملة والفئات الريفية، التي بقيت خارج منظومة الحماية، وهو ما عمّق الفجوة الطبقية في الوصول إلى الخدمات التأمينية.
في مرحلة ما بعد 2003، شهد قطاع التأمين العراقي نموًا كبيرًا في عدد شركات التأمين الخاصة، وشهد أيضًا محاولات لإدخال الرقمنة، لكن هذه التحولات جاءت بمنطق تجاري لا اجتماعي. فقد ظلّت شركات التأمين الخاصة، والشركتين العامتين، تستهدف الطبقة الوسطى والعليا، بينما بقيت الفئات الفقيرة خارج التغطية، إما بسبب ارتفاع الأقساط أو ضعف الثقافة التأمينية.
حتى الآن لم تحدث محاولات الرقمنة تحولاً نوعيًا كبيرًا في اتساع دائرة الشمول التأميني وتقليص الفجوة التأمينية. وكما نوهنا سابقًا فإن الرقمنة، رغم إمكاناتها، تحمل خطر التمييز غير المباشر، إذ أنها تُقصى من لا يملك أدوات رقمية أو حسابات مصرفية من الخدمات التأمينية، ما يخلق "طبقية رقمية" جديدة.
فيما يخص التأمين الصحي فإنه غائب عن الفقراء إذ لا يوجد نظام تأمين صحي شامل في العراق، وهو ما يُعد من أبرز مظاهر البُعد الطبقي ويجعل الفقراء عرضة للكارثة المالية عند المرض. فالفئات الفقيرة تعتمد على مستشفيات الدولة المنهكة، بينما تستفيد الطبقة العليا من التأمين الخاص المرتبط بالمستشفيات الخاصة داخل وخارج العراق. هذا التفاوت في الوصول إلى العلاج يعكس خللًا بنيويًا في وظيفة التأمين كمؤسسة تضامنية.
يكشف تحليل البُعد الطبقي في صناعة التأمين العراقي عن خلل بنيوي في وظيفة التأمين كمؤسسة تضامنية، فهي تعمل بمنطق السوق (تحقيق الربح) لا بمنطق التكافل، وهو ما أدى إلى استبعاد الفئات الهشة من التغطية. ومن رأينا أن هذا الخلل ليس تقنيًا بل سياسيًا ومؤسسيًا، يتطلب إصلاحات تشريعية، ورقابية، وثقافية تعيد تأسيس دور التأمين كأداة للعدالة الاجتماعية. إن تجاوز الطابع النخبوي للتأمين العراقي هو شرط أساسي لبناء منظومة حماية عادلة وشاملة لتجاوز التراتبية الطبقية. إن التأمين هو كمرآة للطبقة والدولة فلا تزال الطبقة العاملة والفلاحين خارج منظومة حماية التأمين كما أن العاملين في القطاع غير الرسمي (وأعدادهم كبيرة) لا يتمتعون بأي نوع من الحماية التأمينية. حتى في القطاع الرسمي، يبقى التأمين مقتصرًا على التقاعد أو على حوادث العمل، دون تغطية صحية أو اجتماعية متكاملة. هذا الوضع يخلق فجوة بين من يملكون وظائف مستقرة (وغالبًا من الطبقة الوسطى أو العليا) ومن يعيشون في الهشاشة الاقتصادية.
الوجه الآخر لغياب التأمين الاجتماعي في الدولة الريعية هو ضعف الثقافة التأمينية insurance culture وتكلفة الثقة cost of trust فالانطباع العام هو أن الكثير من العراقيين لا يثقون بشركات التأمين، خاصة بعد عقود من الفساد وسوء الإدارة. يضاف إلى ذلك، غياب الشفافية، وضعف الرقابة، وتسييس القطاع (وخاصة العام) جعل التأمين يبدو كامتياز طبقي لا كحق اجتماعي. وحتى من له وفر مالي يستطيع دفع أقساط التأمين، يتردد في الاشتراك بسبب غموض العقود وضعف الإنفاذ القانوني weak legal enforcement
هل هناك سياسات للحد من البعد الطبقي في التأمين؟
من رأيي ان غياب البعد الطبقي من رادار التحليل يعني غياب السياسة أو السياسات التي يمكن أن تحد من التفاوت الطبقي في مجال التأمين. إن العمل على دراسة بعض الإجراءات الإصلاحية وصياغة الأدوات المناسبة لتحقيقها على أرض الواقع قد تساهم في تحييد آثار البعد الطبقي (على مستوى قطاع التأمين التجاري). وهنا يرد في البال الآتي:
إصلاح سياسات تسعير المنتج التأميني لضمان شمولية أكبر، ربما من خلال الدعم المتبادل لين فئات المؤمن لهم داخل محفظة التأمين.
- تعزيز التأمين الاجتماعي كجزء من منظومة الحماية الوطنية (من وظائف دولة الرفاه).
- تطوير منتجات تأمينية ميسّرة للفئات ذات الدخل المحدود (من خلال تطوير أشكال من التأمين المتناهي الصغر).
- الرقمنة العادلة التي تراعي الفجوة التقنية بين الطبقات ومنها التحول التدريجي لتطبيقات الرقمنة لمساعدة طالبي التأمين المرتقبين من الفئات الهشة.
أود التنبيه إلى أن هذه الورقة ذات طابع سجالي وليست ورقة بحثية، عمدت فيها إلى إثارة الموضوع بأمل أن يتحفز المهتمون به البحث فيه والكتابة عنه لتكوين فهم أفضل لتاريخ وتطور صناعة التأمين العراقية، ورسم السياسات التأمينية والاجتماعية المناسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[i] Emmett J. Vaughan and Therese M. Vaughan, Fundamentals of Risk and Insurance, Eighth Edition, (New York: John Wiley & Sons, 1990), pp 113-114.
[ii] ستار كرمد عيدان، سوق التأمين العراقية: دراسة في الجذور التأسيسية (مكتبة التأمين العراقي، 2025)
مصباح كمال، أوراق في تاريخ التأمين في العراق: نظرات انتقائية (طبعة الكترونية منقحة مزيدة (2014) صدرت الطبعة الورقية الأولى ضمن منشورات تركة التأمين الوطنية (بغداد 2012)
[iii] مصباح كمال، البحث عن دور اليهود العراقيين في النشاط التأميني، 1920–1970 (مكتبة التأمين العراقي، 2023)