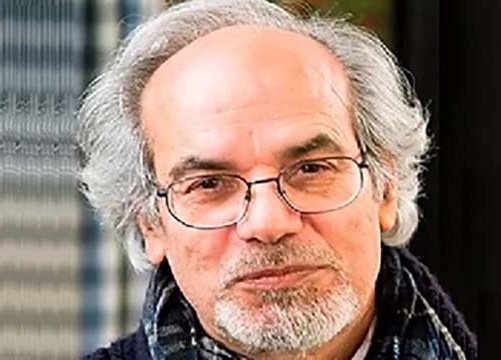
خلال الـ15 سنة الماضية، ومنذ انتشار الإنترنت، بعدما تحوّل كثير من القرّاء العاديين، إلى كتاب وشعراء، في أفق مفتوح وفوضوي لا سلطة لأحد عليه. انبثقت ظاهرة في كل مجتمعات العالم، ومنها مجتمعنا العراقي في الداخل والخارج. ظاهرة اشبه بـ «فقاعة» تتمثل في اصدار كتب في الشعر والقصة والرواية والبحث والنقد، محدودة القيمة حول العمل الثقافي والفني، وتتسبب في خلق نرجسيات فوق نصوص رديئة. ندرك ، انه لم يسبق مطلقا أن تطابقت أذواق البشر وخلفياتهم المعرفية ، لكن الأمر الأهم أيضا أن لا أحد لديه من العمر لأن يقرأ كل ما ينشر، ولذا فإن المراجعات لما تفرزه الساحة العراقية تمنحنا القدرة على الإلمام بأعمال منشورة كثيرة في وقت أقصر، وتوجهنا إلى قراءة عمل ما بتمعن أو حتى تجنب الاستثمار فيه عاطفيا - وماديا أحيانا - مع ذلك فإن مؤلفي ظاهرة الفقاعة( الكتب) - لو وضعنا نرجسية بعضهم جانبا، نرى نصوص ترويجية الطابع كأنما أنتجها كتاب نصوص الإعلانات، تستهدف وقبل شيء تسريع عجلة استهلاك العمل الثقافي كما لو كان منتج مشروبات غازية ، وبناء هالات ساطعة فوق رؤوس نجوم مفترضين دون أدنى اعتبار للقيمة الأدبية أو الفكرية والجمالية لأعمالهم .
مهما كثرت الجهات الناشرة لكتب الشعر والنثر والرواية والدين التي شهدتها الآونة الأخيرة كما الفطر والكمأ، لا تعزز مكانة الكتاب ولا مؤلفه، ولا الثقافة والفكر الذي نتمناه، تمنح حتى للكتاب الناشئين الذين لم يعرفوا بعد كيف تكتب الرواية، او تبنى فيه القصيدة، ولا التفريق بينها من حيث هي فنون أدبية رفيعة لها قواعدها وتقاليدها ومناهجها واساليبها، وبين السواليف المتراكمة بعضها خلف بعض في مخطط عشوائي لا غناء فيه، ولا مزيّة . لقد كشفت لنا عن حقيقة لا يعرفها كثيرون، وهي أن الناشرين هم من يساهم بترشيح هذه الكتب للظهور، وربما يختارون بعد مقايضات ومساومة لطبع ، خمسين اومئة نسخة من الكتاب، لتوزع على الاصدقاء والاقرباء. ولبيان مصداقية هذا الانطباع ، فقد تحولت إلى ألاعيب غايتها دس السم في الدسم، وأن الاحتفالات التكريمية المرافقة للإعلان عن هاتيك المطبوعات لا تعدو أن تكون تظاهرة فاقعة للضحك على الذقون، أو ذرّا للرماد في العيون.
في ما يكتبه البعض من اخوتنا واخواتنا لا يبتعد عن هذه الأجواء. انهم تكاثروا وتهافتوا على النشر تهافت الذباب على الشراب، سرعان ما يبدون حماستهم لنشر أي شىء اسمه( كتاب) مقابل بعض الدولارات، التي يدفعها الكاتب الطموح لاحتلال موطئ قدم في ميدان هذه الفنون الادبية، لا يسألون أنفسهم عما إذا كانت تلك الرواية او قصائد الشعر تصلح للنشر أم للقذف في سلة المهملات. والنتيجة النهائية أننا نجد في المكتبات وفي معارض الكتب روايات ودوواين شعر بعدد الحصى كثرة ووفرة، لكن الجيد من ذلك الكثير أقل من القليل، والمتبقي لا تتجاوز قيمته قيمة الورق الذي استخدم في طباعته ونشره. ان الذين ينشرون من حين لآخر حوارات ساذجة، مصطنعة، ومتكلفة، مع هذا الشاعر أو هذا الكاتب. وقد ضمّن هذه السيرة سيناريو ـ إذا صح التعبير- لمقابلات صحافية هزلية أجراها معه احدهم بائس ذات مرة. وهو بهذا السيناريو يريد أن يثبت، بل يبرهن على حقيقة مفادها أن الغالبية العظمى من أولئك الادعياء الذين يجرون الحوارات مع هذا الشاعر أو ذاك الكاتب، لا يمتلكون الحد الأدنى من الدراية المهنية والثقافية والفكرية بتجربة من يحاورون. علاوة على أن الغالبية الساحقة منهم يفتقرون لأبسط المعارف بفنون الإبداع، من شعر وقصة ورواية. فما جدوى أن يسأل احد هؤلاء الادعياء، كاتبا مبتدءا، ليس له الا شذرات ينشرها في هذا الموقع او ذاك في وسائل التواصل الاجتماعي ،قائلا: متى تكتب؟ أو كيف تكتب؟ أو قدم لنا نفسك للقارئ.. إلخ . أن ما يشد القارئ لهذا الكتاب او ذاك، هو أسلوب السلس العفوي الذي يراوح فيه بين السرد تارة، والشعر النثري تارة، والتوثيق الذي يرتقي من حيث دقته إلى منزلة البحث العلمي والأكاديمي الرصين، تارة أخرى، لا تفارقه في هذا كله السخريه اللاذعة، والمفارقة المدهشة،حيث يتحرر فيه المبدع، المثقف، من سطوة التحايل والسذاجة، وسلطتهما، مطلقا نفسه على سجيتها، فما يستحق ناصية الابداع التي ينبغي له أن لا يتفلت منها، وما يستحق الصرامة الجادة.
قد يعترض البعض بأن نقد هذه الظاهرة هو تفسير وتشخيص، يتبع المزاج، الا اننا وبحكم التجربة المهنية ، نقول: ان وصف الجماليات في العمل الإبداعي، ليست رؤى أخلاقية فقط كما يتوهم البعض، وإنما هي ايضا انتصارا، أو احتضان النصوص الأدبية المعبرة عنها، أو إحياء نصوص أدبية ودينية تمتلك صفات الابداع والاشتغال عليها، أو إعادة قراءة سرديات الكتب المقدسة، وتقديمها للقراء في عالم اليوم، وليس عالم الامس على أنها إجابات لأسئلة ، تتصل بنشاطات اجيالنا الحاضرة.
ولكن السمة الملاحظة في المجمل تلك الروح الاستعلائية غير المنصفة، شديدة القدح لثقافتنا. والغريب في الأمر، أن اصحاب هذه الظاهرة التي تخدعهم بعض المواقع بنشر نصوصهم وقصائدهم تلامسهم حمى النرجسية والعوالم الرومانسية، والأحلام والأماني في القلوب، في صعود مستعجل لايستند الى خبرة ودراسة ليتبوء منصب الكاتب او الشاعر ، ولكنه يتصنع الغفلة لمتطلبات هذه المهنة وابعادها الجمالية،واعماقها الفكرية.
علينا الانتباه إلى أن تجربة الكتابة الأدبية والنقدية والفنية، فهي تمتلك ابوابا مفتوحة للجميع، وتظل متأثرة بالتجارب التي سبقتها، لتكون امتدادا للانجازات الفكرية والفلسفية ، شاء المبدعون أما أبّوا، لأن عليهم تبنيّ بشكل مباشر المذهب والمنهج ، لينطلقوا من مقولاتها ورؤاها، ولم يقفوا موقف الند الجاهل: الذي يناقش وهو يتلقى النظرية بالجهل، ويجادل بدون وعي وخبرة ودراسة في الأصول والقواعد، غير منبهر ولا مستلب حضاريا، لأنه للاسف لا يعي، ان في هذا الموقف مستند إلى ثقافة عربية وعالمية راسخة عميقة الجذور، وارفة الأغصان والظلال، يتحتم عليه الاستفادة والإثراء من تجربة الأدب والنقد ولكن القليل هو من فعل ذلك، وظلت محاولاتهم فردية ومحدودة جاءت على استحياء غالبا.
يصبح النص الروائي والقصائد الشعرية والبحث التاريخي والديني والنقد الفني، بذلك خاضعاً لسلسلة من الإملاءات الثقافية والاجتماعية، والفكرية، والأخلاقية ، بحيث لا ينتفي فيه فعل الحرية الذي هو الحجر الأساس في أي كتابة. ما قيمة نص يخلو من جوهره الذي يحدد ماهيته؟ لا يمكن تخيل رواية بمستوى إنساني محترم دون الحرية التي تحكم صيرورة الكتابة. لهذا، تعاني الكثير من الكتب التي صدرت في الاونة الاخيرة من كثير من المعضلات الثقافية والاجتماعية التي لا يملك لها حلولا، فينشأ اهتزاز داخل دوامتها وتجاذباتها وتنافرها.
المطلوب عراقيا وعربيا، في ظل غياب مؤسسة ثقافية ذات مناخ متخصص مهنيا ،غير متكلسة، تتشبث باي انجاز ، لغرض جرفه الى انجازاتها، فتتحول البنيات التي يراد لها ان تكون مبدعة ومتميزة إلى بنيات متكلسة تثبت ما هو موجود، حتى ولو كان بائسا. المطلوب من الكاتب، الروائي ، الشاعر، الباحث، الناقد، ألا يكتب نصا لا يثير حفيظة المسؤول، أو رجل الدين، أو الحاكم، أو القبيلة. أي، عليه أن لا يكتب نصا مأمورا من نرجسية الذات المستعجلة، ان لايكون، أملسا ولزجا يجيّر الكتابة لغير معناها الثقافي الإنساني. نعم، الكاتب، الشاعر، الباحث، المؤرخ، ليس مبشرا، وليس سياسيا ولكنه الروح العظمى التي توقظ القيم الإنسانية كلما غابت أو كلما تكدست عليها أغبرة الزمن الصعب واللإنساني، يؤنس كل ما فقد إنسانيته واستجابته للروح الحية التي ترى ما لا يراه الآخرون. لانريد منه نصا مغيبا عن حاضره وزمنه لا يحكمه أي شيء، نصاً يعيد إنتاج ما هو سائد ومهيمن ولا يتخطاه أبدا. حتى على الصعيد الأدبي البحت، على الكاتب والشاعر والروائي والباحث والناقد، أن يشتغل ضمن المعطيات الفنيوة الأدبية التقليدية المبدعة، وان لايركض وراء ارشفة التاريخ الشخصي بالمروق على سمات الابداع. أن يكون خلاقا ومبدعا فعالا بالمعنى المحلي والإنساني، ان يبحث كيف يمكن له أن يربي معطيات إنسانية جديدة قادرة على التغيير. وكيف يستطيع أن يكون في صدارة التحولات المجتمعية، من وظائف الأدب والفن والتاريخ أن ينتقد اليقينيات المستهلكة وينشئ مكانها أسئلة إنسانية جديدة تجعل ما ينتجه في واجهة المتغيرات وليس في ذيلها، حيث لا يسود الاسترجاع والتكرار. اتساءل ومعي عدد كبير من مثقفينا وكتابنا المبدعين، الذين قدموا في الاونة الاخيرة عطاءات متميزة في الادب والبحث والدراسات الدينية والفكرية: كيف يمكن لنص مأمور، أملس، مجرد من كل طاقته الإنسانية الخلاقة، كيف يستطيع أن يستوعب كل تناقضات المجتمع المعقدة الكامنة والظاهرة؟
العمل الفكري والادبي، عالم شمولي يفترض نظرة بالاتساع نفسه، وإلا سيضطر النص إلى ارتداء ما ليس على مقاسه. وكلما استجاب لهاجس الشهرة وحدها، أصبح أملس أكثر ملاسة، بلا معنى ولا قابلية للاستمرار ولا التأثير. لان الركض وراء الشهرة ، التي هي أكبر داء يصيب النصوص الملساء هو داء المملاة والانانية والتملق والتعملق الفارغ من فوق، التي تختزل كل شيء بوضعه في خانات مسبقة الصنع، تحرم النص من النظر خارج يقينياتها وأوهامها فتقتله وتنتفي فيه الديمومة ، بمجرد انتهاء الظرفية التي خلقته ورسخته
جوهر الإنسان لم يتغير، ما يزال يبحث عما يخرج إنسانيته من توحشها الأول، ما يزال عرضة للحروب المبيدة، يبحث عن الحب في وضع تحكمه الضغائن. لهذا كله يبدو النص المأمور والراكض وراء الشهرة المجانية ضعيفا ومنهكا وخارج التاريخ، على العكس من النص الحر والمثقل بمسؤولية الكتابة. الكاتب والناقد، عليه ان يعي ثقته وأمله في الحياة وفي الإنسان. فهو من طينة هذه الأرض كبقية المخلوقات، يملك ما تملكه البشرية من طاقات حية، ينكسر من الخيبات الثقيلة، لكنه يقوم منها بقوة أكثر. الكتب وسطوتها ليس بقدرتها على توزيع الورود لإسعاد الجميع، أو نتيجة تحرير التحيا والتهنئات والمباركات لصدور كتاب ما في الساحة الفلانية والفلتانية ، باعتبار أن كلّ شيء فيها جيد لا يعاب، وإنما في طاقتها على مواجهة القارئ وتحديه وربما استفزازه لقبول أشياء جديدة، وإرغامه على التورط في تجارب سحرية على سفن من كلمات.









