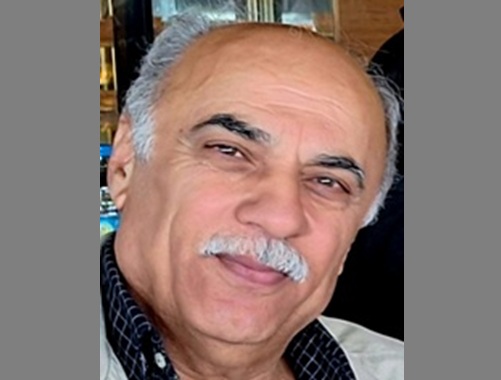
في كل مرة يشتد فيها التوتر الإقليمي، وتلوح في الأفق احتمالات مواجهة عسكرية بين قوى كبرى، نسمع في بلدان مثل لبنان والعراق واليمن أصواتاً تعلن جاهزيتها المسبقة للدخول في أي حرب قد تندلع. طبعا لا يصدر هذا الاعلان بأسم الدولة، ولا عبر مؤسساتها الرسمية، بل بأسم قوى وتنظيمات ترى نفسها معنية بالمعركة أكثر من الدولة نفسها. المشهد، في ظاهره يعكس موقفا سياسيا أو أيديولوجيا، لكنه في جوهره يطرح سؤالا كبيرا ومقلقا: ما الذي تعنيه الدولة بالنسبة لنا ؟ وهل ما زلنا نؤمن بها فعلا ؟
المفارقة الغريبة، أن القوى التي تتجاوز على الدولة في قضايا مصيرية كالحرب والسلم، هي نفسها التي تخوض معارك شرسة من أجل الفوز بوزارة ما أو منصب حكومي، بحيث لا تتوانى عن إشعال الأزمات وتعطيل المؤسسات واستنزاف الموارد والطاقات، فقط من أجل حقيبة وزارية. لكن حينما يتعلّق الأمر بقرار سيادي، يصبح وجود الدولة شكليا وبلا معنى . كأن الدولة مطلوبة فقط عندما تكون مصدر للنفوذ والامتيازات، لا عندما تكون مرجعية وطنية للجميع .
وبهذا الشكل والسياق، لا يجري التعامل مع الدولة بأعتبارها مؤسسات تمثل الجميع، بل بوصفها غنيمة يجب أن تقسم بين المتنفذين. وتتحول الوزارة من مسؤولية عامة، إلى موقع قوة. والمؤسسة من إطار للخدمة، إلى أداة للسيطرة. وهكذا تفقد الدولة معناها الحقيقي، وتتحول من كيان يُفترض به أن ينظّم الاختلاف والتنوع ويحتكر القرار السيادي، إلى ساحة صراع بين جماعات لكل منها مشروعها وولاءاتها الخاصة.
الأخطر من كل ذلك، أن هذا السلوك لا يثير صدمة واسعة داخل المجتمع. ولا تعتبره قطاعات واسعة من الناس تناقضا خطيرا وفاضحا، لأن الدولة في نظرهم لم تكن يوما حاضنة عادلة، لانها لم توفر الحماية للمواطن، ولم تضمن حقوقه، ولم تُشعره بالانتماء الحقيقي. ومع الوقت، تكرّس شعورا عاما بأن الدولة كيان ضعيف أو عاجز أو منحاز، ولا يستحق الثقة ولا الاحترام. لكن السؤال الذي نتهرب منه دائما: هل فشل الدولة يبرر تدمير ما تبقى منها ؟ وهل الاحتماء بالهويات الفرعية هو حل أم تعميق مستمر للازمة ؟
في ظل هذا الواقع، تتراجع فكرة الوطن لحساب انتماءات أخرى. حيث تصبح الطائفة أكثر أمانا من الدولة، والولاء الخارجي أو العابر للحدود يبدو أكثر وضوحا من الانتماء لجغرافيا اسمها الوطن. الأرض لا تعود وطنا، بل ساحة مفتوحة للصراعات، أو ورقة تُستخدم في صراع أكبر لا يملك الناس قرار المشاركة فيه أو الخروج منه.
ما نقدّمه للعالم من خلال هذا المشهد، ليس فقط صورة دول ضعيفة، بل صورة مجتمعات لا تحترم دولها. أعلام ترفرف، ودساتير قائمة ومؤسسات تعمل شكليا، لكن القرار الحقيقي في مكان آخر. الدولة تتحمل وحدها نتائج الحروب والعقوبات والعزلة والانهيار الاقتصادي، بينما يُسحب منها أبسط حقوقها: حق أن تقول (نعم) أو (لا) باسم شعبها.
المشكلة لا تختصر في وجود سلاح خارج إطار الدولة، ولا في تدخلات إقليمية، بل في عقل سياسي لم يحسم خياره : هل يريد دولة أم لا؟ نحن نطالب بدولة تدفع الرواتب، وتؤمّن الخدمات، وتحمي الحدود، لكننا نرفض أن تكون لها الكلمة الأخيرة. نريدها قوية عندما تخدمنا، وضعيفة عندما تختلف معنا. نتمسك بها كغنيمة، ونحتقرها كمرجعية.
بهذا المعنى، الدولة في بلداننا ليست ضحية الخارج فقط، بل ضحية داخلية أيضا. ضحية ثقافة سياسية ترى في الدولة خصما لا بيتا، وفي القانون عائقا لا ضمانة، وفي السيادة مجرد شعار لا ممارسة. ومن دون مواجهة هذا التناقض بوضوح وجرأة، سنبقى ندور في الحلقة نفسها: صراعات بلا قرار وطني، وسلطة بلا دولة، وأوطان معلّقة بين خطاب كبيروشعارات براقة يقابلها واقع مهين.
السؤال لم يعد: لماذا تتدخل القوى الخارجية في شؤوننا؟ بل: لماذا نمنحها هذه الفرصة أصلاً؟









