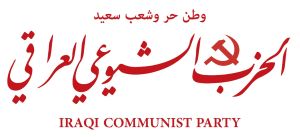جاءت انتخابات 11 تشرين الثاني 2025 في ظرف سياسي وأمني شديد الحساسية، ليس لأنها انتخابات مبكرة كما في 2021، بل لأنها أول اختبار حقيقي لقدرة النظام السياسي على تجديد نفسه من الداخل بعد أكثر من عقدين. وبرغم أن العملية الانتخابية مرّت بهدوء نسبي قياسًا بالسنوات السابقة، فإن نتائجها وما أعقبها من تحركات سياسية أعادت وضع العراق أمام السؤال الجوهري: هل تتجه البلاد نحو إصلاح تدريجي، أم نحو إعادة تدوير الأزمة نفسها؟
ومنذ اللحظة الأولى لإغلاق صناديق الاقتراع، بدت الصورة أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا. فقد تصدّر ائتلاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني النتائج بحصوله على أكبر عدد من المقاعد، لكن من دون أن يحقق أغلبية تخوّله تشكيل حكومة دون الحاجة إلى تحالفات واسعة. هذا التفوّق النسبي يعكس أمرين مترابطين: الأول القبول الشعبي بأداء الحكومة القائمة ورغبة جزء من الرأي العام باستمرار مسار "الإصلاح الهادئ" الذي اعتمده السوداني؛ والثاني هو غياب المنافس الأكبر في الساحة الشيعية، أي التيار الصدري الذي اختار المقاطعة، ما ترك فراغًا سياسيًا استثمرته قوى الإطار وحلفاؤها.
وبعكس انتخابات 2021 التي مثّلت لحظة مفصلية لصعود المستقلين والمدنيين والقوى المنبثقة عن انتفاضة تشرين، جاءت انتخابات 2025 بمؤشرات واضحة على تراجع "نسخة التغيير" لصالح عودة الطبقة السياسية التقليدية إلى تموضعها الطبيعي. فالمستقلون الذين شكلوا عنصر مفاجأة في 2021، لم يتمكنوا من تكرار حضورهم السابق. يعود ذلك لعدة عوامل، أبرزها: انقسامهم، غياب التمويل والتنظيم، عدم تفهمهم لفكر وطروحات المقاطعين للانتخابات، ومع ذلك، لا يمكن القول إن دورهم انتهى تمامًا، لكن بات واضحًا أنهم بحاجة إلى أطر تنظيمية أقوى إذا أرادوا أن يكونوا رقمًا فاعلًا في أي انتخابات مقبلة. والقوى المدنية يجب أن تعي أن التغيير ليس في يوم انتخابي واحد، بل في بناء أُطر مستدامة خارج “الحملة انتخابية". وهناك حاجة ملحّة لتصحيح البيئة السياسية، من شفافية الانتخابات إلى استقلال القضاء إلى سن قوانين جادة لكي يتسنّى للقوى المدنية التنافس بشروط أكثر إنصافًا.
وقد أظهرت النتائج، أن البيت الشيعي لا يزال يعيش لحظة صراع داخلي مكتوم، لكنه أكثر قدرة على إعادة إنتاج وحدته التكتيكية مقارنة بسنوات سابقة. ففي غياب التيار الصدري، تقدّمت القوى المتحالفة مع الإطار وتوزعت الأصوات بينها بطريقة أعادت ترتيب التوازنات داخل هذا المكوّن. ومع ذلك، لم يتشكل "قطب مهيمن" قادر على فرض رؤيته منفردًا، وهو ما يجعل عملية اختيار رئيس الوزراء وتوزيع الحقائب السيادية أكثر تعقيدًا.
في المقابل، شهد البيت الكردي تنافسًا واضحًا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، لكن ضمن سقف يسمح بالحوار والتفاهم مع بغداد. فقد عزز الحزب الديمقراطي موقعه في أربيل ودهوك، بينما احتفظ الاتحاد الوطني بثقله التقليدي في السليمانية، ما يعني أن أي حكومة اتحادية مقبلة ستحتاج إلى صفقة ثلاثية تجمع بغداد وأربيل والسليمانية لضمان الاستقرار السياسي والمالي.
أما في الساحة السنية، فبدا المشهد موزعًا بين أكثر من قطب، مع استمرار التنافس بين القوى التي برزت بعد 2018. وعلى الرغم من تصدر بعض الكيانات في الأنبار ونينوى وصلاح الدين، فإن البيت السني ما زال يفتقر إلى قيادة موحدة يمكنها التفاوض بثقلٍ متماسك، ما يجعل دوره مؤثرًا لكنه غير حاسم في عملية تشكيل الحكومة.
إقليمياً، جرت الانتخابات وسط تزايد حدّة الصراع في المنطقة: الحرب في غزة، التوتر في لبنان، الصدام الأميركي الإيراني المباشر وغير المباشر، والقلق الدولي من مرحلة ما بعد النفط. كل هذه المتغيرات انعكست على العراق بحكم هشاشة بيئته الأمنية واعتماده الاقتصادي الكبير على النفط. وبالتالي، فإن القوى الإقليمية والدولية تابعت الانتخابات بعناية لأنها تدرك أن استقرار العراق جزء من استقرار المنطقة.
وعلى المستوى الشعبي، بقي المزاج العام منقسمًا بين من يرى أن العملية السياسية الحالية، رغم عيوبها، تمنح البلاد قدرًا من الاستقرار، وبين من يعتقد أن استمرار النظام بصيغته الحالية لا يمكن أن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الفشل القديم نفسه.
فالشباب، الذين يشكلون غالبية السكان، لا يرون أثرًا ملموسًا للتغيير في حياتهم اليومية: بطالة مرتفعة، خدمات متعثرة، وفساد يتغلغل في أدق مفاصل الدولة. ومن هنا، فإن الحكومة الجديدة ستواجه صراعات جديدة بين الشارع والسلطة.
والتداعيات السياسية للانتخابات تفتح الباب أمام ثلاث احتمالات رئيسية يمكن أن يتجه لها العراق خلال عام 2026:
الاول: الاستقرار الحذر
وفيه تنجح القوى السياسية في التوصل إلى اتفاق واسع لتشكيل حكومة يقودها السوداني أو شخصية توافقية قريبة منه. هذا الاحتمال سيقدم استقرارًا نسبيًا واستمرارًا للسياسات الاقتصادية والخدمية الحالية، لكنه لن يحقق إصلاحًا عميقًا، وسيقوم على "إدارة الأزمة" لا حلّها.
الثاني: الانسداد السياسي
وفيه تفشل المفاوضات بسبب صراعات المناصب أو التدخلات الإقليمية، ما يعيد العراق إلى أجواء ما بعد 2021: مجلس نواب مشلول، حكومة تصريف أعمال، واحتجاجات شعبية جديدة، قد تكون أكثر حدة وتنظيمًا من سابقاتها تزيد الهوة بين الشعب والطبقة السياسية.
الثالث: بدء إصلاح تدريجي
وهو الأقل احتمالًا لكنه ممكن إذا توفرت ثلاثة شروط: ضغط شعبي منظم، توافق نسبي بين القوى الكبرى على الحد الأدنى من الإصلاح، ودعم دولي موجه لبناء مؤسسات قوية بدل دعم تحالفات سياسية هشة. هذا الاحتمال يمكن أن يبدأ بخطوات صغيرة لكنها مؤثرة، مثل ضبط عمل الفصائل، إصلاح النظام الانتخابي، التعامل مع المحاصصة الطائفية والفساد، وتفعيل الرقابة على المال العام.
وعليه، يمكن القول إن انتخابات 2025 لم تكن نقطة تحول بقدر ما كانت مرآة للواقع العراقي: نظام سياسي قادر على الاستمرار، لكنه غير قادر على تحقيق القفزة المطلوبة نحو دولة حديثة. والمفارقة أن قدرة هذا النظام على التكيف قد تكون مصدر قوته ومكمن ضعفه في آن واحد؛ فهو يملك ما يكفي من الأدوات للبقاء، لكنه يفتقر للإرادة الكافية للتغيير.
العراق اليوم أمام فرصة تاريخية، ربما تكون الأخيرة قبل أن تتراكم الأزمات إلى مستوى يصعب السيطرة عليه. فالمواطن الذي انتظر تحسن الخدمات وتراجع الفساد يريد أن يرى خطوة واحدة على الأقل تعيد له ثقته بمؤسسات الدولة. والسياسي الذي يخشى الفوضى عليه أن يدرك أن الاستقرار الحقيقي لا يأتي من المحاصصة، بل من القدرة على بناء مؤسسات قوية وعادلة.
وهكذا، فإن انتخابات 11 تشرين الثاني 2025 ليست نهاية المطاف، بل بداية مرحلة جديدة عنوانها: هل يختار العراق طريق التغيير التدريجي نحو دولة قادرة، أم يظل أسير تدوير الأزمات؟
17 تشرين الثاني 2025