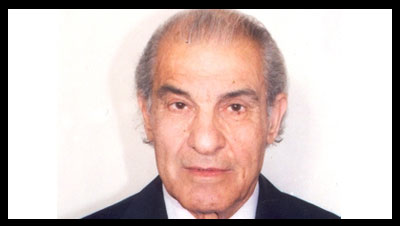
الشخصية الوطنية والاجتماعية والقيادي السابق في الحزب الشيوعي العراقي
(1)
بدايةً بودي تثمين (الثقافة الجديدة) على مبادرتها هذه، خصوصاً وانها تهدف الى “التحريض على تقليب الأوراق من جديد، وتقديم قراءات جديدة” عن الحدث الكبير في تاريخ العراق الحديث، ثورة 14 تموز 1958. وطرحت العديد من الاسئلة، التي تشكل الاجابة عليها، بمجموعها، وربما بإضافة اسئلة اخرى، الهدف من طرح الموضوع. وليس من شك ان الاجابة المطلوبة لا تكفيها ثلاثة آلاف كلمة، ولذا من الطبيعي ان يقتصر الأمر، في هذه الحدود، على بعض الاسئلة، وباختصار نسبياً.
اول الاسئلة: هل ما حدث في ثورة 14 تموز 1968 كان انقلاباً ام ثورة؟ وأجيب بأن كان ثورة. ذلك ان نوري السعيد، بعودته الى رئاسة الحكومة في صيف 1954 بضغط شديد من السفيرين الانجليزي والامريكي على الوصي عبد الاله، سد كل الطرق التي يمكن استخدامها لاجراء التغيير الذي ينشده الشعب، والتخلص من السيطرة الاستعمارية المتمثلة بحلف بغداد، والنظام شبه الاقطاعي الذي يسود البلاد. واجرى “انتخابات” مزيفة جعلت مجلس النواب يخلو من أية معارضة. خصوصاً بعد فوز المعارضة الوطنية بعشرة مقاعد في البرلمان، المكون من 136 مقعداً! الأمر الذي دفع السيد نجيب الصائغ، وكان يومها سفيراً في وزارة الخارجية، الى سؤال نوري السعيد، هل من المعقول ان يخلو مجلس النواب من معارض واحد، في حين انه كان يحوي في عشرينات القرن العشرين بضعة عشر نائباً، وكذلك في سنوات الثلاثينات والاربعينات والنصف الأول من الخمسينات.
لقد كان الشعار الذي وضعه الرفيق فهد في الاربعينات “قووا تنظيم حزبكم، قووا تنظيم الحركة الوطنية” وتحقق في العام 1948 وأمكن بواسطته إِشعال وثبة كانون الثاني 1948 التي اسقطت وزارة صالح جبر، ومعاهدة بورتسموث التي اراد الاستعماريون الانجليز فرضها على العراق، بدلاً من معاهدة الذل والعبودية، معاهدة 1930.
هذه الوثبة الوطنية التي عمل نوري السعيد على الرد عليها واعلان الاحكام العرفية، بذريعة حماية مؤخرة الجيش الذي زُعم ان بعض وحداته اُرسلت الى فلسطين لمنع قيام اسرائيل، وفقاً لقرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، في حين انه كان في الواقع لمنع الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الوطنية المستقلة استناداً الى نفس القرار، بدليل ان قيادة الجيوش العربية التي اُرسلت الى فلسطين كانت بقيادة الجنرال البريطاني كلوب باشا (ابو حنيك). وأجرى نوري السعيد انتقامه الاجرامي من الحركة الوطنية بالاحكام العرفية الاجرامية ضد مجموع الحركة الوطنية، وإعدام قيادة الحزب الشيوعي العراقي: الرفاق الأماجد يوسف سلمان (فهد) ومحمد زكي بسيم (حازم) وحسين محمد الشبيبي (صارم) الذين اقتيدوا من سجن الكوت، حيث كانوا يقضون محكومياتهم، الى محكمة عرفية عسكرية اصدرت احكامها التعسفية الاجرامية بإعدامهم، وتنفيذ حكم الاعدام الاجرامي في 14 شباط 1949.
ورغم الجراح التي عاني منها الحزب الشيوعي العراقي واصل الاهتداء بشعار “قووا تنظيم حزبكم، قووا تنظيم الحركة الوطنية”، وقيادة انتفاضة خريف 1952، التي اسقطت وزارتين خلال أقل من اسبوع، واضطرت الفئة الحاكمة، وعلى رأسها الوصي عبد الاله ونوري السعيد، الى اللجوء الى الجيش واقامة حكومة عسكرية بقيادة رئيس اركان الجيش نورالدين محمود، والقيام بأوسع حملة اعتقالات في تاريخ العراق، حتى ذلك الوقت، شملت كل قادة الاحزاب الوطنية العلنية وحلها، واعتقال مئات الشيوعيين.
لقد جئت في بداية المقال على ما جرى في صيف 1954 على يد نوري السعيد، وكونه سد الطريق السلمي لاجراء أي تغيير في العراق، وهو ما كان يتبناه الحزب الشيوعي حتى خريف 1956، الأمر الذي حمل الحزب على تصفية الانقسام في صفوف الحركة الشيوعية، والعمل على تشكيل الجبهة الوطنية الموحدة التي ضمت حزبنا الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال وحزب البعث العربي الاشتراكي، الجبهة التي سعى حزبنا الى ضم الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) الذي كان يمثل الحركة القومية الكردية يوم ذاك إليها، غير ان الحزبين القوميين العربيين الاستقلال والبعث رفضا ذلك، مما حمل الحزب الشيوعي على التحالف مع الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني لضم جهوده الى الجبهة. وكان اعلان الجبهة في ربيع 1957. وشكل هذا الاعلان تجسيد وحدة الحركة الوطنية.
ورافق ذلك تحرك الضباط الاحرار بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم، الذي كان على صلة بحزبنا وبالجبهة الوطنية.
واتذكر ان الشهيد سلام عادل قال انه عرض على عبد الكريم قاسم ان يقوم الحزب بالتحرك المسلح ضد النظام، وأن يتلقى الدعم من حركة الضباط الاحرار. غير ان عبد الكريم قاسم رفض ذلك قائلاً: انه هو من سيتولى البدء بالتحرك طالباً من الحزب وجبهة الاتحاد الوطني دعمه بالتظاهر.
وهكذا كان. وعندما اُذيع البيان الأول للثورة في 14 تموز 1958، هبّ الشعب عن بكرة أبيه، فامتلأت شوارع بغداد، والعديد من مدن العراق، منذ الساعات الأولى من الصباح، بالمتظاهرين دعماً للثورة.
الأمر الذي يعني ان ما جرى ذلك الصباح لم يكن انقلاباً عسكرياً بمعزل عن القوى السياسية المنظمة في جبهة الاتحاد الوطني، وعن برنامجها الوطني. وكان تركيب الوزارة الاولى التي اعلنها عبد الكريم قاسم تضم ممثلين عن قوى جبهة الاتحاد الوطني كلها، عدا الحزب الشيوعي العراقي، وإن ضمّت وزيراً يسارياً ماركسياً معروفاً هو الفقيد ابراهيم كبه.
كما ان ما أقدمت عليه حكومة الثورة، منذ اليوم الأول لتوليها السلطة، وفي اسابيعها الأولى من خطوات تكشف عن كونها ثورة وطنية ديمقراطية وطابعها المعادي للامبريالية والاقطاع، وخصوصاً قانون الاصلاح الزراعي – رغم نواقصه – ومساهمة الفلاحين في تطبيقه، قبل الأجهزة الحكومية، وانطلاق الحركة النقابية العمالية، ومنظمات الشبيبة والطلبة وانصار السلام وغيرها.
الأمر الذي يجعل ما جرى في 14 تموز 1958 في العراق يختلف عما جرى من انقلابات عسكرية في مصر وسوريا وغيرها، التي اتخذ بعضها طابعاً معادياً للامبريالية وتبنى بعض ما تطالب به الحركة الوطنية الديمقراطية في البلد المعين فيما بعد.
(2)
ما هو دور عبد الكريم قاسم والضباط الاحرار في إنجاح الثورة، وايضاً في المآل المأساوي لها؟
ان دور عبد الكريم قاسم كان دوراً أساسياً في إنجاح الثورة، وفي المآل المأساوي لها ايضاً.
ذلك انه رفض منذ البداية ان تكون المبادرة للقوى السياسية، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي، في البدء بالثورة – كما سبق وذكرت – وأصر على ان تكون المبادرة من قبل الجيش. وليس كل الجيش، او كل الضباط الاحرار، بل ان يكون هو المبادر، مستخدماً العقيد عبد السلام عارف، دون الضباط الاحرار الآخرين. اذ لم يشكل مجلساً لقيادة الثورة برئاسته، ولم يتح للضباط الاحرار الآخرين تشكيل تنظيم، بل اعتمد في تشكيل الحكومة (الوزارة) على قوى جبهة الاتحاد الوطني برئاسته، واستصدار دستور مؤقت لا يقيده بشىء، مما ترك المجال ليكون زعيماً أوحداً للبلاد. ولا بأس من التذكير، في هذا المجال، بأن عبد السلام عارف هو أول من اطلق شعار “ماكو زعيم الاّ كريم”، الذي تلقفته الجماهير وعارضت به مساعي عبد السلام عارف، وكل القوميين من اتباع عبد الناصر والبعثيين، الذين رفعوا شعار الوحدة، بشعار “اتحاد فدرالي صداقة سوفيتية، عاش نصير السلام عبد الكريم قاسم”. هذا الشعار الذي رددته جماهير الحزب الشيوعي في اول مظاهرة جماهيرية للرد على شعار الوحدة الذي رفعه البعثيون بتحريض من ميشيل عفلق، في الخامس من آب 1958 على ما اتذكر.
واتذكر ايضاً اني كنت المكلف حزبياً، وكنت يومها في قيادة منظمة بغداد، بإطلاق المظاهرة الجماهيرية، التي انطلقت في 5 آب 1958 من حديقة الملك غازي في الباب الشرقي حتى وزارة الدفاع. وخرج عبد الكريم قاسم اكثر من مرة لالقاء خطب قصيرة. هذه المظاهرة التي قدّر عدد المشاركين فيها من قبل وسائل الاعلام بربع مليون متظاهر. الأمر الذي اعتبره الفقيد كامل الجادرجي أمراً مبالغاً به، كما يذكر الفقيد عامر عبد الله، لأن شارع الرشيد بطوله وعرضه مع ساحة وزارة الدفاع لا يمكن أن يتسع لأكثر من 150 ألف متظاهر. وعندها، كما ينقل عامر عبد الله، انه قال للجادرجي “150 ألف. هَم أنعم الله”.
كما ذكر هاني الفكيكي ان البعث، وكان هو من قيادته يومذاك، قرر تحشيد قواه للتظاهر في مدخل وزارة الدفاع، قائلاً “عندما ذهبنا الى وزارة الدفاع، وجدنا ان الشيوعيين وانصارهم ملأوا الساحة”.
لم نكن ندرك في ذلك الصراع الحاد الذي اشعله يومذاك القوميون، وفي مقدمتهم عبد السلام والبعثيون، من جهة، والشيوعيون والديمقراطيون من جهة اخرى، خطورة انشقاق القوى الوطنية، والصراع فيما بينها على مسيرة الثورة، حرصاً منا على تطويرها، ولم نكن نصغي لبعض الأمور التي تحمل المخاطر الجدية على الثورة، وعلى الحياة الديمقراطية والحزبية.
من ذلك مثلاً، ما نقله حلاق عبد الكريم قاسم، الذي يحتل محله مدخل دربونة العمّار في شارع الرشيد مجاوراً لمحل عمل احد اقاربي، حيث نقل الحلاق انه شكا لعبد الكريم الضجة التي تثيرها الاحزاب في صراعاتها، عندما ذهب لحلاقة الزعيم في وزارة الدفاع، الذي قال “انتظر، لن تبقى الأمور هكذا”. بما يعني انه لن يدع الاحزاب المتصارعة! وقد ظهر أثر ذلك بعد أقل من سنة، في اعقاب احباط مؤامرة الشواف في الموصل بطرح شعار تجميد الحياة الحزبية، الذي حظي بتأييد الشخصية الوطنية الديمقراطية، وزير المالية يومذاك الفقيد محمد حديد. هذا الشعار الذي اعتبره حزبنا مؤامرة عليه، وعلى الحريات الديمقراطية.
ولابد في هذا السياق من ذكر السلوك المتطرف الذي انغمر فيه رفاقنا في الموصل، وقيامهم بدور سلطة، وتشكيلهم محكمة حاكمت المتآمرين، ونفذت ببعضهم حكم الاعدام. الأمر الذي ردت عليه القوى اليمينية والرجعية، فيما بعد، باغتيال مئات الشيوعيين وتشريد عوائلهم في ظل سكوت سلطات عبد الكريم قاسم وتغاضيها عن جرائمهم.
كما ان دور عبد الكريم قاسم وبعض الضباط الأحرار في المآل المأساوي لثورة 14 تموز 1958 كان دوراً أساسياً، سواء في إصراره على الانفراد بالسلطة والحيلولة دون إقامة نظام ديمقراطي يعتمد على انتخاب الشعب لممثليه في السلطة، الأمر الذي عزله عن اوساط متزايدة بدرجة أن يضطر قطب الحزب الوطني التقدمي محمد حديد الى الاستقالة من الوزارة، مما أبكى عبد الكريم قاسم، دون ان يحول الى تغيير نهجه الخاطىء في “العفو عما سلف” وتمكين المتآمرين من تولي مناصب خطيرة في الجيش، بإسم التوازن، تمكّنهم من الاقلاب عليه. واكثر من هذا انهيار أحد هؤلاء المتآمرين، واعترافه له بالمتآمرين الآخرين. وتملك قاسم الغرور الى درجة الامتناع عن إبعادهم عن المراكز الخطيرة التي يحتلونها، منتظراً تحركهم ليضربهم! متوهماً انه من الممكن تكرار ما حدث في الموصل من قمع انقلاب عبد الوهاب الشواف، الذي تعاون مع القوميين والبعثيين وعملاء عبد الناصر لتحقيق تآمره.
وكان سلوك عبد الكريم قاسم بعد بدء انقلاب 8 شباط 1963 تكملة لنجه الخاطىء المدمر الذي سمح بقيام الانقلاب ونجاحه. وذلك بصم أذنيه عن خطاب الألوف من الجماهير المحتشدة في وزارة الدفاع التي منعت اول دبابة من دبابات الانقلابيين من الوصول الى مقر قاسم، وكانت تهتف “باسم العامل والفلاح يا زعيم اعطينا سلاح”، معتبراً ان اعطاءها السلاح يعني حرباً اهلية. متناسياً ان الحرب الاهلية قامت بالفعل، وان السلاح ظل بيد المتآمرين فقط، وحُرمت منه الجماهير الشعبية، التي اوقع بها الانقلاب الكثير من الضحايا البريئة. ومن ثم عشرات الألوف ممن اعتقلوا وعذّبوا واغتيلوا تحت التعذيب من القوى الوطنية الديمقراطية وفي مقدمتهم الشيوعيون.
ولا بأس من ذكر ما كشف عنه مؤخراً لأول مرة هذا العام، أحد انصار قاسم من انه – أي قاسم – رفض الاستماع الى طلب ممثل الاتحاد السوفيتي في بغداد يومذاك للاتصال بالزعيم وعرض مساعدته في مجابهة الانقلاب!
كما ان دور الضباط الاحرار كان مهماً في إنجاح الثورة، ذلك انهم وقفوا الى جانب تحرك قاسم ودعموه في البداية، بأمل ان يستعين بهم في قيادة أمور البلد. غير ان الكثيرين منهم خابت آمالهم عندما شهدوا انفراد عبد الكريم قاسم بالسلطة، فمال بعضهم الى العمل الانقلابي ضده بالتعاون مع عملاء الاستعمار، وعملاء عبد الناصر كما كشفت الاحداث.
(3)
ما هو البعد الديمقراطي في الثورة، ولماذا اخفقت في بناء نظام سياسي ديمقراطي؟
سبق لي ان كتبت في هذا الموضوع مقالاً في (الثقافة الجديدة) في العدد 289 الصادر في تموز – آب 1999، أعادت المجلة نشره في العدد 390-391 تموز 2017 في باب نصوص قديمة. وكان المقال بعنوان “في ذكرى ثورة تموز، الفرصة الضائعة لإقامة الديمقراطية”.
استميح القارىء لاقتباس بعض فقراته لعلاقتها بالسؤال المطروح في بداية هذا المقال. وإن كان في هذا بعض التكرار لما سبق في الجزء الاول في هذا المقال.
بعد استعراض نضال الشعب العراقي في سبيل اقامة النظام الديمقراطي بدءاً بثورة العشرين ووثبة كانون الثاني 1948 وانتفاضة تشرين 1952 وانتخابات 1954، التي افلحت فيها المعارضة الوطنية بمختلف تياراتها، بما فيها الشيوعيون، عندما وحّدت صفوفها في الانتخابات وفازت بعشرة مقاعد في البرلمان المكون من 138 مقعداً، وعودة نوري السعيد لتولي رئاسة الوزراء في اعقاب هذه الانتخابات بضغط فظ ومباشر من السفيرين البريطاني والامريكي على الوصي عبد الاله، لحل البرلمان بعد عقد جلسة واحدة فقط، وتعطيل اكثر من مئة صحيفة وغلق الاحزاب، بما فيها حزب نوري السعيد نفسه، والجمعيات وتعطيل النقابات العمالية واسقاط الجنسية عن عدد من المناضلين الوطنيين، وفي مقدمتهم الشيوعيون، وغيرها من الاجراءات التعسفية المعادية للديمقراطية وحريات الشعب، وقمع تطلعه للديمقراطية. “وبذلك – يقول المقال – سدّت الفئة الحاكمة الملكية الطريق على أي تغيير سلمي للسلطة نحو الديمقراطية، يؤمّن للشعب حقوقه الديمقراطية في حكم نفسه عن طريق ممثليه المنتخبين بارادته الحرة”.
كان الحزب الشيوعي العراقي حتى خريف 1956 يتمسك بالطريق السلمي لإحداث التغيير الديمقراطي الذي ينشده الشعب والقوى الوطنية الديمقراطية، وهو ما جرى الاتفاق عليه بين اطراف جبهة الاتحاد الوطني التي قامت في اعقاب انتفاضة 1956 دعماً لمصر الشقيقة في إقدامها على تأميم قناة السويس، والوقوف بوجه العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الصهيوني.
غير ان ما اقدمت عليه الفئة الحاكمة بقيادة نوري السعيد وعبد الاله من وحشية سافرة من قمع تطلع الشعب الى الديمقراطية جعلت الحزب يتبنى ضرورة استخدام القوة لإزاحة النظام الملكي، والبحث عن امكانية التعاون مع الضباط الاحرار بقيادة عبد الكريم قاسم لتحقيق ذلك.
ويقول المقال المشار اليه “وقد أجمعت القوى الوطنية في جبهة الاتحاد الوطني والجيش على ضرورة اسقاط الحكم الملكي، واقامة حكومة وطنية ديمقراطية تُخرج العراق من حلف بغداد، وتحافظ على استقلال البلاد وتتضامن مع الشقيقتين مصر وسوريا قبل قيام الوحدة بينهما، وبالتعاون مع الجمهورية العربية المتحدة بعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا. ولم تحوِ برامج جبهة الاتحاد الوطني والضباط الاحرار أي شعار يدعو الى وحدة اندماجية بين العراق والجمهورية العربية المتحدة بعد تحريره من حلف بغداد والحكم الممالىء للامبريالية”. يستطرد المقال الى القول: “ولذا كان من المفروض ان تنشغل القوى الوطنية المتحالفة في جبهة الاتحاد الوطني، بعد نجاح ثورة 14 تموز 1958، التي شكلت هذه القوى قاعدتها السياسية العريضة، وعبأت الجماهير لاستقبال تحرك الضباط الوطنيين الاحرار بقيادة عبد الكريم قاسم في 14 تموز 1958، بذلك الموج المتعاظم من ابناء الشعب بمختلف ميولهم واتجاهاتهم السياسية الوطنية، وان تنشغل بإقامة النظام الديمقراطي، من حريات ديمقراطية وومؤسسات دستورية كمهمة أولى، تمهد لانجاز المهمات الاخرى لتعزيز استقلال البلاد والخروج من حلف بغداد، وإنهاض الاقتصاد الوطني والقضاء على نفوذ الاقطاعيين وتجريدهم من سيطرتهم على الاراضي الزراعية، التي هي ملك الشعب، والنهوض بالتعليم، والوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي للغالبية الساحقة من ابناء الشعب”.
“غير ان ما حصل هو غير هذا مع الأسف، اذ انشغلت القوى الوطنية، منذ البداية، بالخلاف حول الشعار الذي رفعه حزب البعث العربي الاشتراكي بتحريض من عفلق وإصراره، وعبد السلام عارف، الداعي الى الوحدة الاندماجية والفورية مع الجمهورية العربية المتحدة. الأمر الذي اضطر القوى الديمقراطية – وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي – الى طرح شعار الاتحاد الفدرالي”.
“وكان الدافع لطرح الشعار هو تفادي فرض وحدة اندماجية بقرار فوقي تتخذه مجموعة صغيرة من الضباط والعاملين في الحقل السياسي،، على الضد من ارادة الشعب، يلغي وجود الجمهورية العراقية الفتية ويكبح تطلع شعبنا الى اقامة نظام ديمقراطي يتمتع فيه بحرياته الديمقراطية، ويؤمّن الحقوق القومية للشعب الكردي عن طريق الحكم الذاتي، والحقوق الادارية والثقافية للتركمان والاشوريين والكلدان”.
كما يقول المقال “ولذا فان شعار الاتحاد الفدرالي هو، بمعنى ما، يعكس التطلع لإقامة نظام ديمقراطي وحياة حزبية شرعية في ظل الحريات الديمقراطية .. الخ”.
“ومن المؤسف ان هذا الخلاف لم يبق في حدود الصراع الفكري حوله، والعمل على كسب الجماهير الى جانب هذا الشعار او ذاك بالطرق الديمقراطية، بل تعداه الى الانتقال للتخطيط لانتزاع السلطة من عبد الكريم قاسم، التي كانت تحظى بتأييد شعبي هائل، وسلوك طريق التآمر لتحقيق ذلك، ومجابهة ذلك بالعنف المبالغ فيه وغير المبرر في بعض الاحيان، الذي ساهم فيه الحزب الشيوعي العراقي باسم “الدفاع عن الثورة” و”صيانة الجمهورية”.
“وأدت النوازع الفردية للحكم لدى قاسم وتخوفه من تنامي نفوذ القوى اليسارية، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي، الى مزيد من الاجراءات المعادية للديمقراطية، والاستعانة بعناصر وقوى تنتمي الى الحكم الملكي البائد واللجوء الى لعبة التوازن التي كانت تعني إطلاق أيدي القوى الرجعية والمعادية للديمقراطية، وسياسة “عفا الله عما سلف”. ولم تكن هذه القوى، رجعية كانت او قومية، تعرضت للتنكيل المبالغ فيه بسبب نشاطاتها التآمرية مستعدة للقبول بأقل من القضاء على حكم قاسم وتصفية الحزب الشيوعي العراقي.”
“وزاد الأمر سوءاً وتعقيداً اندلاع الصدامات في كردستان، التي بدأتها عناصر اقطاعية معادية للاصلاح الزراعي (مرتبطة بايران)، ومن ثم انضم الحزب الديمقراطي الكردستاني اليها واعطاها طابعاً قومياً يطالب بالحقوق القومية للشعب الكردي، وتحولت الى حرب مدمرة.”
“وهنا كان ايضاً الشعار الذي رفعه الحزب الشيوعي العراقي (السلم في كردستان) ونظّم من اجله العرائض الجماهيرية بعشرات ألوف التواقيع، والمظاهرات الضخمة، التي أدت ببعض المشاركين فيها من المناضلين المعروفين والوجوه الثقافية الى السجون تنفيذاً لأحكام مجالس عرفية نصّب فيها قاسم عناصر معادية له وللديمقراطية تطبيقاً لسياسة التوازن التي أشرنا اليها سابقاً.”
“أقول هنا ايضا كان هذا الشعار (السلم في كردستان) يستهدف تخليص الوطن من كارثة الحرب ضد الشعب الكردي وتمهيد الاوضاع لنضال اكثر فعالية من اجل الحد من تسلط عبد الكريم قاسم على السلطة، وبناء حياة ديمقراطية صحيحة، تتيح العمل السياسي لكل القوى السياسية في البلاد في ظل الحريات الديمقراطية وسيادة القانون وتشريع دستور دائم للبلاد.”
ويخلص المقال الى القول: “غير ان الوعي في الحركة الوطنية ككل، بكل فصائلها، مع تفاوت في درجة مسؤولية كل فصيل عما حدث، كان دون المستوى المطلوب لإنجاح الثورة في تحقيق مهمة اقامة النظام الديمقراطي المنشود.”
“ولم يكن هذا بمعزل، بطبيعة الحال، عن التمسك بالمصالح الطبقية الضيقة من قبل البورجوازية الوطنية العراقية، ورغبة العناصر القومية في التحكم بمسيرة الثورة دون سند جماهيري، بل بالاعتماد على تدخلات القوى الخارجية ودعمها، وفي مقدمتها قيادة عفلق والقوى الناصرية. وكذلك حقد العناصر الرجعية والدوائر الامبريالية على ثورة 14 تموز، ومساعيها الحثيثة (أي مساعي هذه العناصر والدوائر) لإثارة الفرقة بين قوى الثورة وتفجير الصراعات فيما بينها، واستغلال الثغرات الخطيرة في نهج حكومة عبد الكريم قاسم للتآمر عليها وإنجاح انقلابها المشؤوم في 8 شباط 1963. هذا الانقلاب الذي وجّه أكبر ضربة للحركة الديمقراطية في العراق، ما زالت آثارها بادية للعيان حتى الآن.” (أي في العام 2018 وليس فقط تاريخ كتابة المقال في تموز 1999).
وهكذا يمكن القول بكل ثقة ان تجربة ثورة 14 تموز 1958 تجربة غنية جداً بايجابياتها، اذ كانت حصيلة وحدة نشاط قوى المعارضة الوطنية، وحققت لشعبنا الكثير من المنجزات، وبسلبياتها الخطيرة، وفي مقدمتها احتراب القوى التي فجّرتها فيما بينها، وتضييعها فرصة اقامة النظام الديمقراطي الذي ينشده الشعب وفتحها الطريق لتولي الدكتاتوريات التي اوصلت وطننا وشعبنا الى الوضع الكارثي الذي يعاني منه الجميع.”
(4)
ما هي العوامل والقوى الخارجية الداعمة للثورة والمناهضة لها؟ النشاط الامبريالي ودوره في عرقلة الثورة والوصول الى غايتها في تحرير العراق من الهيمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
بودي الاجابة عن هذين السؤالين باختصار جهد الإمكان التزاماً بالحجم الذي حددت هيئة التحرير.
كانت القوى الامبريالية قد خططت للسيطرة على العراق، وكبح نشاط القوى الوطنية الهادف الى تحريره منها. ولذا اقامت حلف بغداد الذي ضم العراق وايران وتركيا وباكستان وبريطانيا العظمى. وكانت الولايات المتحدة الامريكية تدعمه، دون ان تكون عضواً رسمياً فيه شكلاً.
ولهذا فقد اقدمت الولايات المتحدة الامريكية على إنزال قواتها العسكرية في لبنان، وبريطانيا على إنزال قواتها في الاردن فوراً، بعد نجاح الثورة في العراق، خشية انهيار الحكم في هذين البلدين تحت تأثير انتصار الثورة العراقية في 14 تموز 1958. وواصلت بعد ذلك العمل على إضعاف الحكم الجديد الذي جاءت به الثورة، ومنعه من تعميق نهجه الثوري وتعزيز منجزاته ما امكنها ذلك.
في حين وقف الاتحاد السوفيتي ودول المنظومة الاشتراكية والصين والحركة العمالية والتحررية العالمية الى جانب الثورة. وجرى تحذير تركيا من قبل الاتحاد السوفيتي من القيام بأي عمل معادي للثورة.
هذا الموقف الذي قوبل بحماس وامتنان كبيرين من جانب الجماهير العراقية تجسد بحمل سيارة السفير السوفيتي بمن فيها عندما توجه لتقديم اوراق اعترافه بالحكم الجديد، إعراباً عن ذلك، دع عنك ما قدمه المعسكر الاشتراكي، وفي مقدمته الاتحاد السوفيتي، يومذاك، من مساعدات سياسية واقتصادية وعسكرية دعماً للثورة وحكومتها ومساعدتها على انجاز المهمات التي تواجهها على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري.
فإلى جانب الإعراب عن الوقوف بحزم لحماية الثورة والوضع الجديد، وتقديم المساعدات الاقتصادية ودعم ما اقدمت عليه حكومة الثورة من تأميم كل الاراضي التي كانت خاضعة لامتيازات شركات النفط الاستعمارية عدا التي كانت قيد الاستثمار الفعلي من قبل هذه الشركات، كان عقد اتفاقيات التعاون الاقتصادي التي دعمت الاقتصاد العراقي دعماً كبيراً في اكثر من مجال.
اما عن دور النشاط الامبريالي في عرقلة الثورة في الوصول الى غايتها في تحرير العراق من الهيمنة السياسية والاقتصادية الاجنبية والتآمر لإسقاط حكومة عبد الكريم قاسم، فبودي أن أشير، اقتصاداً بالوقت، الى كتاب “التدخل السري للولايات المتحدة في العراق خلال الفترة 1958 – 1963، جذور تغيير النظام في العراق الحديث بدعم من الولايات المتحدة الامريكية”. وهو اطروحة اكاديمية بقلم الباحث ويليام زيمان، وترجمة عبد الجليل البدري – 2013. الكتاب الذي “يسلّط الضوء على التعاون الوثيق بين حزب البعث ووكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي آي أي) للإطاحة بحكومة عبد الكريم قاسم وتصفية منجزاتها، وخاصة ما يُعرف بالقانون رقم (80) الذي سحب امتيازات التنقيب عن النفط في الاراضي العراقية من الشركات الاجنبية خارج ما كانت تستثمره فعلاً. وهو ما سبق ان جئت على ذكره قبل قليل.
وهدف البحث الذي ضمّه الكتاب هو “تبيان حقيقة الدعم المادي الذي تلقاه حزب البعث ومن وكالة المخابرات المركزية، سواءً قبل وبعد الانقلاب، او في فترات مختلفة خلال السنوات الخمس من حكم قاسم، وقيام الوكالة بعمليات سرية ضد العراق”.
وأشار الكتاب الى كتاب حنا بطاطو “الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية في العراق” والى تأكيدات العاهل الاردني الملك حسين بأن وكالة المخابرات المركزية التقت مراراً مع حزب البعث. والى ما اخبر هاشم جواد وزير الخارجية ايام قاسم المؤلف “بأن وزارة الخارجية العراقية كانت لديها معلومات عن وجود تواطؤ بين البعث ووكالة المخابرات المركزية (سي آي أي). وفي عام 1987 نشرت ماريون وبيتر سلاكليت كتابهما (العراق منذ 1958)، وهو عبارة عن تاريخ كامل يلخص ضلوع الولايات المتحدة في الانقلاب البعثي عام 1963.
ويذكر المؤلف ويليام زيمان ان الفلسطيني سعيد ك. ابو ريش يُعد من اكثر المؤلفين إحاطة بموضوع التدخل الامريكي في العراق خلال الفترة الممتدة من 1958 الى 1963، فان كتابيه (صداقة وحشية: الغرب والنخبة العربية) الصادر عام 1997، و(صدام حسين: سياسة الانتقام) الصادر عام 2000 يعترفان بما ورد في بحوث كتاب سابقين مثل مالك المفتي وحنا بطاطو ومحمد حسنين هيكل وماريون وبيتر سلاكليت. ونضيف ما حصل عليه من مقابلات عديدة مع مسؤول الشرق الاوسط في وكالة المخابرات المركزية خلال عام 1963، وهاني الفكيكي عضو قيادة البعث خلال عام 1963 والعديد من الامريكان والعراقيين الآخرين.
ولا يفوتني ان أورد ما صرح به علي صالح السعدي، القائد البعثي، الذي قال “جئنا الى السلطة بقطار امريكي”.
ويذكر الكتاب الكثير من الوقائع والشخصيات العاملة في وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي)، وعلاقاتها ونشاطاتها في اصطياد البعثيين، مما لا داعي للتفصيل فيه في هذا المجال. ولكني لا استطيع ان استبعد شهادة قائد بعثي سوري، اذ ورد في الكتاب ما يلي: “وبصرف النظر عن طريقة الـ (سي آي أي) في اصطياد البعثيين العراقيين فقد وصل نبأ لقاءاتهم الى القادة البعثيين في دمشق، واحتدم الجدل بين البعث السوري والبعث العراقي. ويروي القائد البعثي جمال الاتاسي، الذي كان وزيراً في الحكومة السورية وقتذاك تلك النقاشات قائلاً:
“عندما اكتشفنا هذا الأمر، بدأنا بمناقشتهم (أي البعثيين العراقيين – الكاتب عبد الرزاق) وكانوا يبررون تعاونهم مع وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) والولايات المتحدة بأنه لغرض اسقاط عبد الكريم قاسم والاستيلاء على الحكم. كانوا يقارنون ذلك بكيفية وصول لينين بقطار الماني للقيام بثورته قائلين انهم وصلوا بقطار امريكي”.
اكتفي بهذا القدر عن الدور الامريكي خشية الإطالة، اذ لابد من ذكر دور بريطانيا باختصار، اذ يذكر المؤلف ان “تنسيب عملاء الى وكالة المخابرات الامريكية هي طريقة اخرى ساعدت بها بريطانيا في انقلاب 1963 في العراق”. ويقيناً انها ليست الطريقة الوحيدة التي قامت بها بريطانيا في العمل ضد الثورة العراقية وضد حكومة عبد الكريم قاسم.
اكتفي بهذا المقدار، حرصاً على عدم تجاوز الحد الذي حددته هيئة التحرير لحجم المقال، آملاً ان اكون قدمت مساهمة متواضعة في ملف الثقافة الجديدة لمناسبة الذكرى الستين لثورة 14 تموز 1958 المجيدة.









