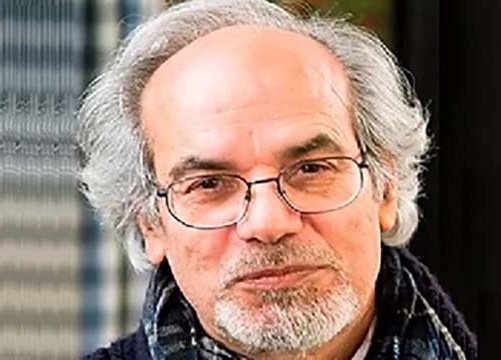
الغرق بمسألة الاداء ومسخ الشكلية التقنية الغربية
جديد على الواقع الاوربي ان يقدم المبدع المهاجر الى المشاهد الاوربي بصفته الابداعية وبقدرته على اثراء الواقع الثقافي للبلد الذي رمته ظروف الهجرة في احضانه الى جانب كونه يمتلك مشاكل جوهرية اخرى تتعلق بمعاناته اليومية كمهاجر محاط بتركيبة ضيقة الافق. الا ان الملاحظ ان النشاط الفني الذي يراد منه عكس تجربة المبدعين من ابناء العالم الثالث، قد اغرق نفسه من قبل عدد من الفنانين بمسألة الاداء ومسخ الشكلية التقنية الغربية. فبالقدر الذي تجاوزت في الكثير من الخصوصيات المتعلقة بطبيعة وبنية العالم الثالث نفسه، فإن العديد من هؤلاء الفنانين اشاحو بنظرهم عن تلك الخصوصيات وكأنهم غير معنيين اساسا برصد التمخضات والتحولات داخل مجتمعاتهم، وبالتالي ابتعدوا عن الهدف الاساسي الا وهو الكشف عن الهوية المختلفة لفنان العالم الثالث امام المشاهد الغربي. وقد سعى القليل من المبدعين، في الرسم الى التركيز على بعض الملامح الشرقية، ذات الطابع الفلكلوري البحت.اما في الفن المفاهيمي، فان اغلب التجارب الفنية العربية تكاد تكون ممسوخة عن التجارب الغربية.
هل يحق لنا ان نبحث في خصوصية لانتاج مبدع من العالم الثالث؟ وهل هناك خيطا ورابطا لايمكن لفنان العالم الثالث ان يفلت منه، او ان يتماثل رغما عنه بالمبدع الاوربي، الا وهو التحولات الخاجية، فنحن محاطون بمجتمع في حالة حركة وبحث وقلق خارجي، في حين ان المبدع الاوربي لانه يعياش تجربة مستقرة نسبيا فانه لايلتفت كثيرا الى ما يحدث خارجه، اذ ان اهتمامه الاساسي انسحب الى عالمه الداخلي، عالم الذاكرة اللاواعي، الحلم، التجربة الخاصة الفردية، ذلك ان الخارج غير قادر على اثارة دهشته؟ هل هذا هو الحد الفاصل ما بيننا، نحن نتابع بهم ما يحدث خارجنا، في حين اننا غير قادرين ان نعكس الخط الفاصل والمميز بين عالمين؟
يمكن للقارىء ان يكتشف غنى وتعدد الاراء الجمالية التي يخلقها الفنانون العرب في بلدان الاغتراب في رهانهم على التعدد والخصوصية والاختلاف ، في تنويع الاساليب وإثرائها بروافد المنجز الغربي ومرجعيات الخصوصيات القومية والوطنية. ثلاثة من العاملين في الجماليات والنقد التشكيلي استطلعنا آراءهم :
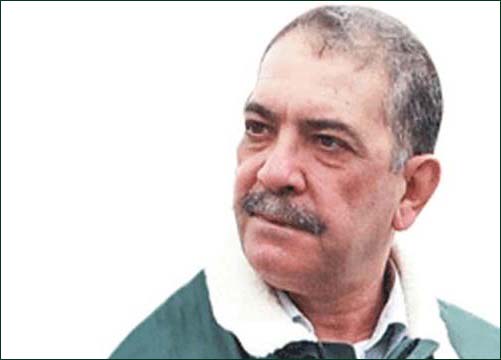 الناقد التشكيلي الشاعر فاروق يوسف
الناقد التشكيلي الشاعر فاروق يوسف
(هوية فردية لا هوية جماعية)
أفهم أن السؤال يتعلق بالهوية القلقة أو المزاحة. لنقل مبدئيا إن سؤال الهوية الفنية كان على الأقل بالنسبة للعالم العربي سؤالا سياسيا ملفقا. فرضته الأحزاب على الفن من غير أن يفكر فيه الفنانون إلا بطريقة عرضية سببت الكثير من المشكلات في علاقتهم بالحداثة الفنية. كان ذلك بابا دخل من خلاله الجمهور العادي لكي يكون حكما على أصالة الأعمال الفنية بمعنى السماح لنوع من ال"الشعبوية" بمواجهة "نخبوية الفن". لكن ذلك لم يكن ضروريا بالنسبة للفنان العربي المقيم في أوروبا. سيكون على ذلك الفنان أن يخلص لوجوده ولحساسيته الإنسانية ولمشاعره ويصدق في اعترافاته لو أنه تماهى مع ما تعلمه وما أعجب به وما سعى إلى أن يكون جزءا منه. أي أن يكون أوروبيا على المستوى التفكير في الفن. فبغض النظر عن النظريات التي ألحقت بتجارب الفنانين العرب الرواد فإن تلك التجارب من جهة التقنية والمعالجات كانت أوروبية خالصة. ولأن الفن ليس موضوعه فإن الموضوع لن يكون مقياسا للأصالة. اما الربط بين الموضوع المحلي والهوية الفنية فإنه عبارة عن كذبة ملفقة. فأنت على سبيل المثال ترسم لا لترى بل لتكتشف. وهنا تلعب أدوات الاكتشاف دورا مهما في التعريف بالفن وخصوصياته. الفنان العربي في مثل تلك الحالة لا يملك سوى أن يتفاعل مع ما يجري من حوله من ممارسات مختبرية داخل المحترف الاوروبي. اما إذا اختار العزلة والتفكير في ماضيه الذي تغلب عليه العاطفة الإنشائية فإنه يكون قد قرر أن يوقف الساعة ويخرج من الزمن. ما حدث أن قلة من الفنانين العرب استطاعت أن تكسر الحدود الزائفة وتتبنى الحقيقة. وهي القلة التي عاشت زمنها الخقيقي وتماهت مع المكان الذي تعمل وتعيش فيه وأدارت ظهرها إلى العالم العربي. أما الأكثرية فإنها تقيم في أوروبا وعينها على الأسواق الفنية العربية. لست هنا بمنكر أو مستنكر لما يجده البعض حلا لأزمته الاقتصادية بشرط أن لا يتم ذلك من خلال التمويه بقيم فنية وجمالية وفكرية تتعلق بمسألة الهوية الجماعية التي هي من وجهة نظري مجرد وهم بالنسبة للفنانين العرب. أؤيد أن يكون لكل فنان عربي هويته. ذلك طبيعي بل ومطلوب. اما استعارة مفردات الفنون اليدوية الشعبية فإنها لا تشكل طريقا سوية يصل المرء من خلالها إلى هويته.
 الفنان الكاتب طلال معلا
الفنان الكاتب طلال معلا
مقاربة هذا الموضوع على صلة بالآثار الاجتماعية للفنون بما تطرحه من حجج على صلة بالهوية من جهة وشروط الانتماء والتفاعل مع هذه الهوية، ومهما حاولنا أن نمنح الأمر بعض التجاوزات الإنسانية بفعل المواطنة العالمية المطروحة وأثرها على فهم الفنون المعاصرة إلا أن الأمر يبقى في أعماقه على ارتباط بالإفرازات العاطفية التي يمكن أن تتبادلها الشعوب والأفراد في صلاتهم ببعضهم البعض وفق شروط المناقشات التي باتت تحددها المؤسسات الفنية وتتحكم بها آليات تنفس الأسواق الفنية وكل مايشكل الهرم الدرامي للثقافات الإنسانية وفق مفاهيم مابعد الحداثة.
أنا لاأحاول أن أجد مبررا لما نعيشه على أرض الواقع. بالصلة مع القيمين والمنسقين وحتى نقاد الصالات والمتاحف وسواهم ممن يعالجون القضايا بناء على اتفاقات فيما بينهم دون أية قيمة للتحسن الحضاري والأخلاقي المفترض التعامل من خلاله باعتبار الإبداع المعاصر إبداعاً تشاركياً ينتمي فيه الفنان إلى ذاته المتحولة فيما يمكن أن ندعوه الترابط الاجتماعي الإنساني القائم على استقلال الفنون عبر تاريخه المشترك والذي مازال حتى اليوم يخضع لمركزيات دون أخرى وبالتالي فإن عملية قبول الآخر إنما تنضوي تحت هذا الإشكال الذي يصنف الفنون في تاريخيتها وفق نظم القوة السياسية أو الاستعمارية أو الاقتصادية وليس عبر الكيفيات الإبداعية والحضارية للمجتمعات. هذا إذا لم نأخذ في الحسبان ماتعرفه هذه الدول على التعليم الأكاديمي الفني ودعم المؤسسات والمتاحف والبيناليات وأجهزة الإعلام وما يشتمل على الصناعات الثقافية والاستثمارية المرتبطة بالفنون بأشكالها المختلفة.
في الأدوار الاجتماعية التي نعيشها اليوم يتم التركيز على الفنون باعتبارها قوة اقتصادية وتغييرية للمجتمعات وقيمة ثقافية على مستوى الهوية وهنا يكمن مصدر القلق الذي أشرت إليه باعتبار أن فنانيهم هم الأوصياء على أحلامهم بل إن بعض نقادهم ذهبوا إلى أن الفنون الوطنية في الغرب هي مقياس صحة وسلامة تلك المجتمعات، بل هي مايمنحه التفرد والترويج الذاتي الجماعي في السياقات الاجتماعية والمؤسساتية. فيما الفنون في مجتمعاتنا تقدر غالباً بأقل من قيمتها بكثير، بل إن بعضها مجمد دون وعي. لأهميتها، ومعنى أن تكون دعماً وسنداً للفنانين في بلدانهم، وفي ترحالهم وتنقلهم، وهم يحملون معهم المعاني الإنسانية والروحية، ويتوقعون من الآخرين ضيافة تنبع من عمق روحي مشترك، ليجدوا أنفسهم في عالم مليء بالمخاوف، وأحيانا بالعنف، فتزداد الحاجة للشعور بضرورة مواجهة الواقع الجديد، والدفاع عن ضرورات العيش، متعطشين للسلام وهم الهاربين من واقع مليء بالحروب والصراعات وانعدام الحريات، وكل مايدفع المبدعين لمغادرة أرضهم وأوطانهم، والبحث عن استقرار في عوالم لايجدون فيها الا التحدي، وانعدام الحوار والاعتراف بقيم التعدد والتنوع التي تنادي بها المنظمات الدولية، ليبقى النداء نداء، وتبقى الحيرة تعرقل الذين يبحثون عن إمكانية الاستقرار بسلام، كي يشاركوا في تفعيل وتطوير المحترفات الإبداعية التي يفدون إليها، والتي تبقى سدًا منيعاً في قبولهم، وكأن اتفاقاً دولياً فيما بينهم يقتضي بإقصائهم، فيعيشون غرباء ومنفيين في الواقع الجديد.
 الكاتب الشاعر شاكر لعيبي
الكاتب الشاعر شاكر لعيبي
قد تبدو حيثيات السؤال للبعض مشحونة بمفاهيم فكرية عريضة، لعلها بعيدة قليلا عن الجماليات، بل هي أقرب للأيديولوجي والسياسي بالمعنى المكروه الممنوح حاليا في الثقافة العربية للأيديولوجي والسياسي. شخصيا لم أفهم يوماً علاقة (الفن) التشكيلي (بالواقع) بالمصطلحات والمفاهيم السائدة مسبقة الصنع. فهي علاقة معقدة تستحق بالفعل المساءلة، وأود فهم السؤال بهذه الدلالة المعقدة ذات المستويات المتعددة.
لكن قد تبدو عناصر السؤال الحالي مشتتة: من جهة يجري الحديث عن (الفن المهاجر) و(العالم الثالث)، ومن جهة أخرى تجري الإشارة في السياق نفسه الى (مسخ التقنية الغربية) في هذا الفن. وفي الحقيقة فإن (مسخ) هذه التقنية الحداثية الغربية ليس رهنا ولا حكرا على العالم الثالث المهاجر، فالعالم الغربي يلقي بظلاله بقوة كبيرة على العالم كله، الثالث وغير الثالث، وعلى كل صعيد: الفن، الموضة، الطعام، احتكار اللغة، توحيد المفاهيم على كل مستوى، المسارات الاجتماعية والروحية والجنسانية...الخ. ستعلق الأمر بهيمنة شاملة لا يبدو أن أي عالم ثالث محصّن ضدها، خاصة وأنه منقطع الجذور عن أفضل ما في إرثه التشكيلي التاريخي، أو هو، هذا العالم، يستعيد الفلكلوري والفن ذا الطبع المقدس منه، لذا يصير بداهة أن يقلد تشكيليا الآخر المتفوق. وإذا كانت جماليات مجتمعاتنا جامدة وفق هذه الوضعية، فإن التحولات الاجتماعية والسياسية بالأحرى في هذه المجتمعات تسير وفق النسق نفسه بل بطريقة أسوأ، فلا فنانونا بباطنيّ وحلميّ النزعة، ولا هم في تماس جمالي وتأمليّ في معالجة مشكلات الواقع.
العمل الفني بالأصل والضرورة هو عمل فردي، هو انتعاش الحرية من الداخل أولا، ومازالت تفصلنا مسافات كبيرة عن إدراك مغزى الفردانية ومفهوم اكتمال الحرية بإبعادها المعقدة.









