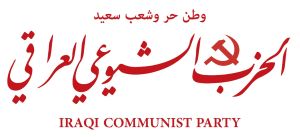في مشروعنا النقدي، والذي أطلقناه في (كتاب كولاج تأويل) لا نواجه المنجز الإبداعي برؤية نقدية مسبقة جاهزة قائمة على محددات ومقاييس فكرية وفلسفية وفنية، كي يخضع المنجز الإبداعي لمتطلَّباتها. بل نشكِّلُ رؤيتنا، من المنجز الماثل أمامنا، لان النص النقدي لاحق لسابقٍ هو المنجز الإبداعي. (النقد وفق ما نراه، عملية فحص تنقيبي في المنجز الإبداعي (النص) بغية كشف أهم ملامح تفرّدهِ عمّا قبله، ومن دون تصورات مسبقة تُخْضِعُ النصّ لمحددات أو ثوابت نظرية أو تطبيقة ما.
بوصفه (أي النقد) لاحق لسابقه (النص) منه يستمد كشوفاتِه الرؤيوية، وآليات كتابة نصوصه التأويلية. غير أنه لاحقٌ محايدٌ منتجٌ لتأويلٍ خصب، وليس منحازاً لتصوّرٍ مانعٍ لحرية التأويل)1.
في الشرقِ يَكثُرُ الشعراءُ، لهول ما يتكدّسُ من أحلامٍ مؤجلةٍ في الشوارع. بفضلِ براعة (الخاصةِ) في الضّحِكِ على (العامةِ). يحدث هذا منذ أقدمِ الأزمنةِ، وضمن مناخ ٍ مفبركٍ بشعائر مُضَبَّبَةٍ مأخوذةٍ من نصوص متوارثةٍ. نصوص تزيدُ من هيمنة العالي على الواطئ، وتكرّسُ الخطأَ بهالاتِ قداسةٍ، تجرِّمُ حتى من يفكرُ في امتطاءِ عدمِ رضاهُ. وتسمحُ للحاكمِ على إعادةِ كتابتها أيضا، خدمةً لدوامِ امتطائه لقطيعِ رعيته، عبر افتعالِ أزماتٍ تُحَرِّفُ الأبصارَ عن سوادِ مراميهِ. هذا ليس غريبا على أغلبِ أوطانِ الشرقِ، التي عادة ما تتحول الى أماكنَ طاردةٍ لأبنائها، فَيدبّونَ في أرضِ الشَّتاتِ، طلبا لملاذٍ آمنٍ، يستعيدونَ فيه بعضا من آدميَّتهم المفقودةِ.
بعد مدخلنا أعلاه، نسعى لإجراءٍ فاحصٍ لبعضِ إصدارات الشاعر (فضل خلف جبر) وفق عدةِ كولاجات تأويل، واستدراكٍ، ثمَّ ملحقٍ رؤيويٍّ، وكما يلي:
الغربة وكتابه الأول/ كولاج تأويل أول:
الشاعرُ فضل خلف جبر لمْ يتمكَّنْ من تحمُّلِ أعباءِ وجودِهِ في وطنه، فهاجر الى اليمن قبلَ أن يتسلَّمَ جائزة مجلةِ "الأقلامِ" عام 1992 عن نصِّهِ (انكسرتُ فسالَ جنوني) ثمَّ غادرَهُ مقيما في أمريكا. الهجرةُ منحتْهُ فرصةِ اصدارِ أولِ كتبه الشعرية المخطوطة الكثيرةِ، وهو كتاب (حالما أعبرُ النشيدَ) الذي هيمنت فيهِ القصائدُ المقطعية التي تنتهي بانقلابٍ لافتٍ مثيرٍ للدهشة، المسماة بالضربة أو الومضةِ الشعرية. كما كشفَ لنا عن ابتعادهِ المقصود عن تصوراته الأولى بجوهر الشعر ووظيفتهِ الاتصاليةِ، فلم نجدْ فيه أو في أيٍّ من كتبه الصادرة الأخرى، أيةَ قصيدةٍ عمودية، تلكَ التي كان بارعا في كتابتها آنذاك.
هذا يعني أن الشاعرَ رفضَ المناخَ الشعريّ المزيف منذ الثمانينات وما تلاها من سنواتٍ مريرةٍ، كانت فيها قصيدةُ التفعيلةِ تنافسُ القصيدةَ العاميةَ في تجميلِ وجهِ النظامِ الكريهِ. أي أنه رفضَ أن يكونَ شاعرَ قبيلةٍ أو جماعةٍ أو سلطةٍ، فتبنّى قصيدةَ النَّثرِ، التي تتمرَّدُ على الأنساق المركزية للعالمِ المعيش، والتي تنفرُ منها الذائقةُ التقليديةُ المحكومةُ برنينِ القِيَمِ والأعرافِ السائدةِ المتوارثةِ، والمانعةِ للتفكيرِ. تتحلّى قصائد كتابهِ أعلاه، بنكهة لاذعةٍ من سياقاتِ النظامِ الشّمولي المُغَيِّبةِ لحقوقِ الانسانِ في العيشِ الرَّغيدِ، نتيجة آليَّة التَّجَبُّرِ والروتين المقيت بين السائلِ والمسؤولِ.
(مَرَّتْ ثلاثُ صحارى
وأربعةُ فصولٍ
وسبعةُ أمطارٍ
ورأسُ البَصَلِ ينمو في عريضةِ الفلّاحِ
فوقَ مكتب الرَّجلِ ذي العلامةِ الفارقَةِ) ص33 <حالما أعبرُ النَّشيدَ>.
آثاريون / كولاج تأويل ثانٍ:
في كتاب (آثاريون) يواصلُ الشاعرُ ايغالَهُ في ولوجِ مسالك قصيدة النثر، فيقدِّم لنا القصيدةَ ذات المتنِ الطويل، التي تتطلب منه وضعَ القطنِ على أذنيهِ كي لا يسمع ضجيجَ صالاتِ شعرِ المديحِ المريبةِ. وأن ينصرفَ تماما الى مشغلهِ العابقِ بالتجريبِ. وهذا الكتاب يتضمن ثلاثةَ أعمالٍ شعرية، الأول (انكسرتُ فسالَ جنوني) والذي يكشفُ عن قدرةِ مطاولةٍ على عرضِ مفاتنَ متنٍ طويلٍ، تتنافسُ فيه أنساقٌ جماليةٌ عابقةٌ بما هو انساني وكوني ونبيل. والعمل الثاني عنوانه (بغالٌ مجنَّحَةٌ) وهو نصٌّ طويلٌ أيضا، فيه تهكمٌ ومواربةٌ فنيةٌ، للتعبير عن الراهن العراقي المرعبِ والمريبِ آنذاك. بيتنا العمل الثالثُ الذي حمل عنوان الكتاب (آثاريون) الذي يتكونُ من مجموعة نصوصٍ، تتباينُ في أنساقها وأطوالها وكيفيات تناولِها للموضوعاتِ التي نالت اهتمام الشاعر. فهو هنا لا ينتمي الى محدِّداتٍ ما تعيقُ تطلّعاتهِ الكونيةِ الدّاعيةِ الى نُصرةِ الانسان المُستلبِ الذي، تَحَوَّلَ جَسدُهُ الى ملعبٍ لصراعِ مآربِ الطُّغاةِ، دونَ مقابل.
(حتى متى
تُصنعُ أحذيةُ الجنرالاتِ
من جلودنا؟!
لنوقفَ هذه المهزلةَ
ليست لنا
جلودُ وحيدِ القرنِ) ص79 <آثاريون>-.
من أجلِ سطوع الذّهبِ/ كولاج تأويل ثالث:
بينما تجتمع في كتاب (من أجلِ سطوعِ الذّهبِ) نصوص المتن الواحد غير الطويل، وتبدو وكأنها كُتِبتْ باسترخاءٍ وتَأنٍّ، لأنها تشكَّلَتْ بعدسةٍ فاحصةٍ، وفَّرَتْ صورا عدة، مكَّنَتْ منتج النص من خلقِ مشاهدَ خصبةٍ في متابعتها لمجريات الأحداثِ خلال التسعينات. وعلى الرغمِ من أن الغربةَ قد أخذتْ مأخذا من الشاعر، إلّا أننا – في معظم النصوص- نجدُ أن مخيلتَهُ مازالتْ تهفو لبلادهِ ولمدينته الناصرية. لكنهُ عاجزٌ تجاهَ ما يجري من كوارث تتعاقبُ على تخريب بلاده، وليس أمامه سوى افتراضِ عوالمَ تواصلٍ ولُقْيا معها، كلَّ حينٍ.
(أيتها الشمسُ، يا ابنةَ الأعالي
قولي لذلك الطيارُ الأمريكي
الذي قطعَ البحارَ والمحيطاتِ والقاراتِ
ليدافعَ عن نفسهِ في سماءِ العراق
أن يتركَ لنا شجرةَ آدمٍ، شجرةَ أدمٍ لا أكثر
لنستدلَّ بها على فواجعِنا
حينَ نعودُ من التّيهِ الأكبر بين سندانِ المنفى
ومطرقةِ الحنينِ) ص21 <من أجلِ سطوعِ الذهبِ>.
طق إصبع/ كولاج تأويل رابع:
أما في كتاب (طق إصبع) فيتبيّنُ لنا جنوحهُ الملحوظِ نحوَ التجريب، وانصرافهِ القصدي الى ورشةٍ معرفيةٍ خالصةٍ ضمنَ مشغلهِ الكتابي. حيثُ الانهماك الأركيولوجي في واحدةٍ من لُقى الإرثِ السومريِّ الخصبِ. فالشاعر يضعُنا أمامَ أيقونةِ عنونةٍ ضاربةٍ في شتى تنويعاتِ الطقوسِ السومريةِ. وهذه الأيقونةُ نراها جالسةً على متنٍ مكوّنٍ من ألواحٍ شعريةٍ تتعالقُ في أنساقها مع أنساقِ المدوناتِ. وتكشفُ عن سعيٍ كتابيٍّ جادٍّ، لدحضِ منظومةِ الحزنِ المتسلِّطَةِ على حياتنا منذُ عقودٍ، بمنظومةِ فرحٍ لا تخلو منها الذاكرةُ الجمعيةُ.
هذا النَّصُّ المستخلصُ من بينِ ركامِ هذه الذاكرة، هو محاولة الشاعر لأسطرَةِ النص الشعري المعاصر، كي يواجهَ نصوصَ الحزنِ المُمِلِّ، الذي تغذّيه السلطاتُ الشموليةُ بمختلفِ انتماءاتها، وأساليبها الشرسةِ.
(طق.. طق.. طق
ينهمرُ الأزلُ من سكونِهِ
وتتجلّى صفحاتٌ مطويةٌ من غيابِ وجهِ الرَّنَّةِ
حيثُ للصوتِ رائحةُ الجُّمّارِ
وللرّنَّةِ عطرٌ يفوحُ كما البرق في ثنايا الغيمِ) ص7 <طق إصبع>.
استدراك:
ولابد لنا من الوقوف عند تجربة الشاعر على مستوى اللغةِ، وفيها حاولَ التَّعاملَ مع مفرداتٍ مستهلَكَةٍ في اللغةِ المحكيةِ، لتكوين تراكيبَ شعريةٍ، تنتجُ دهشةً اتصاليةً. وهذا يتمثَّلُ في أغلبِ كتبِه، أو في عناوينِ بعضِ القصائد، مثل: (سيرة شخصية للسيد مدري يا هو) أو (وِلْيَةْ غُمّان) أو (المنفضة بدرجة700 بههيهايت) وسواها. ويحاولُ أيضا الإفادةَ من اللغةِ الرقميةِ في الانترنيت، استجابةً للمتغيراتِ التقنيةِ والمعلوماتيةِ المتسارعةِ في منظومةِ الاتصالاتِ بشتى تنويعاتها.
لقد عمل الشاعر على إحياء المفردات المهملة من اللغة العامية، من خلال دمجها بمفردات وجمل من اللغة الفصحى، لخلق جمل شعرية جديدة لا تخلو من (فنتازيا) تعبيرية مدهشة اتصاليا. وذلك لما تتمتع به من تأثير سحري على المتلقي، بالابتعاد عن المألوف بالإفادة من عمق صلاتها به، وتسليط الضوء على عدم الاستقرار والتناقض واللاعقلانية فيه. (إن التأثير الأولي للفنتازيا هو ابتعادها عن المألوف. أما تأثير الفنتازيا الأهم والأروع فمصدرُهُ صلاتها بما هو مألوف، والطريقة التي تسلِّطُ بها الضوءَ على عدم الاستقرار والتناقض أو حتى اللاعقلانية التي ينطوي عليها المألوف)2.
ملحق رؤيوي:
الشاعر (فضل خلف جبر) استطاعَ مبكِّرا، أن يتخلّصَ من شبكةِ إغراءاتِ قصيدة الصالةِ، صوبَ قصيدةِ التّمردِ. وذلك لتعلّمه اللغة الإنكليزية، كلغةٍ أدبيةٍ أخرى، والتي فتحتْ له آفاقا جديدةً، مكَّنَتهُ من الاطلاعِ على منجزِ شعراء الغربِ، خاصةً كتّاب قصيدة النثرِ. وكذلك التّعَرّف على التّحوّلاتِ الجديدة في الفكر الأوربي، والهزّاتِ المعرفية الفلسفية التي زحزحتْ اللاهوتَ عن عرشهِ الدكتاتوري، ومنحت الفكرَ الجديد أسبابَ تحرُّرهِ نحو قراءاتٍ عدّةٍ للوجود والعالم. وهو يدرك مدى تصلّبِ مواقف منظومةِ الفكر العربي التي استمدَّتْ جبروتها من ضراوةِ المناخِ القبلي. ومن ثمَّ تدرَّعَتْ بشبكةٍ متوارثةٍ من المحرَّماتِ المبثوثةِ من مؤسساتِ <دين السلطةِ>.
فوجد شاعرنا في قصيدةِ النثرِ والترجمةِ مَلاذَهُ الخصب، لتحقيق تطلّعاتِهِ الجمالية ذات البعدِ الإنساني، بعيدا عن المحدّداتِ والموانعِ التي تختلقها السلطات القانعة للآخر، وذلك لإدامةِ تواجدها على رأسِ هرمِ انصياعِ القطيعِ للراعي. فأرادَ أن يكون له موقف جمالي تجاه الحياة أولا والنص الفائت والراهن والآتي ثانيا، وهو موقف فلسفي واجتماعي وثقافي يعبر عنه من خلال سلوكه ونصه الشعري الخاص به. بمعنى أن يكون موقفا إنسانيا وكذلك ابداعيا بعيدا عن فخاخ الترغيب والترهيب، لأن غاية الفن المثلى، هي جمالية خالصة. حيث (يذهب بعض المفكرين الى أنهُ من المهم أن نتَّخذَ موقفا جماليا تجاه كلِّ الأشياء دون استثناء)3.
ولعلَّنا في هذا الاجراءِ الفاحصِ العجولِ، ردّدْنا بعضَ وفائه ومحبته الكبيرة لوطنه، على الرغم قسوتِهِ عليه وعلى أغلبِ أبنائه العاشقين له، لما عانوه من أمكنةٍ جورٍ وحرمانٍ طاردةٍ، دفعتهم الى الهجرة الى أراضي الشتات. وربما استطعنا من إزالة الضبابِ عن منجزِ شاعرٍ جديرٍ بالاهتمام والفحص، لما ينطوي عليه منجزهُ، من تنويعات اشتغال جادة، في التجريب المتواصل، والابتكار الشعري المتجدّد.
------------
إشارات:
1- كتاب (كولاج تأويل) علي شبيب ورد/ مشروع نقدي/ دار تموز للطباعة والنشر/ دمشق 2013.
2- كتاب (أدب الفنتازيا) ت. ي. أبتر/ ترجمة: صبار سعدون السعدون/ دار المأمون للترجمة والنشر/ بغداد 1989/ ص191.
3- كتاب (دليل أكسفورد في الفلسفة) الجزء الثاني/ تحرير: تِد هُنْدرتْش/ ترجمة: د. نجيب الحصادي/ هيأة البحرين للثقافة والآثار/ ط1/ المنامة 2021/ ص1479.