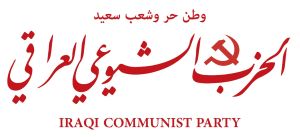د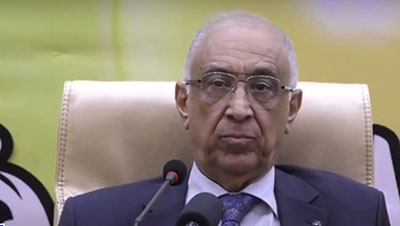
التاريخُ هو الوقائعُ في تتابعها ، وفي ترابطها ؛ وهو أيضًا وعيُ الإنسانِ ذلك ؛ وليس حتمًا أن يطابقَ الوعيُ الوقائعَ في التتابع والترابط ؛ وإنّما هو يقترب منها بمقدار ما تُتيحُه وسائلُ المعرفة ، وبمقدار قدرةِ الإنسانِ على الفهم والاستيعاب .
ولقد صحِبَ التاريخُ الإنسان منذ نشأ ، وأدرك أنّ من الحوادث سابقًا ولاحقًا ، وأنّ سببًا ما يربط اللاحقَ بالسابق . وإذ نشأت الكتابة والتدوين أخذ نفر من ذوي النباهة يدوّنون الحوادثَ على نحو ما رأوا ، أو سمعوا . وانصرف التدوينُ في بداءة الأمر إلى الحوادثِ الكبرى كالحرب والغزو ، وقيامِ الممالك ، ودمارِها ، وكلِّ ما يتّصل بالنصر والهزيمة . وبهذا المنحى وُضِعتْ كتبُ التاريخ ؛ تسجّل قيامَ الدول واندثارها ، وظلّت زمنًا طويلًا لا تُعنى بغير ذلك . ثمّ اتّسعت الرؤيةُ ، وامتدّ الفكر ، فظهر من يدوّن الشأن الاجتماعيّ ، والشأن الاقتصاديّ ، ويكتب تاريخ الحِرَف في نشأتها وتطوّرها ، ويضع تاريخ الأفكار ؛ حتّى صار لكلِّ شيءٍ تاريخٌ ! فلمّا كان القرنُ التاسع عشر تمّ للتارخ كيانُه ، وأخذ مكانةً رفيعة ، وجعلت الأشياء لا تُفهم إلّا بسياق من تاريخها ؛ إذ ينظر الدارسُ إلى النشأة وما يلتبس بها ، وإلى الانتقال من حال إلى أخرى ؛ وهو في ذلك كلّه لا ينظر إلى ما يدرس منفصلًا عمّا حوله ، بل يراه في مشتبك علائقه بما يُحيط به ؛ حتّى الكائنات الحيّة صار لها تاريخ حين وضع دارون كتابه " أصل الأنواع " ، ونشره في سنة 1859 . وإذ أراد ماركس أن يفهمَ المجتمع القائم ، في بنيته واصطراعه ، أخذ يرجِع في الزمانِ إلى أصل نشوء الاجتماع البشري ، وإلى تحوّله ، من بعد ، من حال إلى أخرى . وجعل من يكتب تاريخ الفكر يصل بين الأفكار وبيئتها ، ويضعها على نحو من الترتيب بحيث ينشأ اللاحقُ عن السابق ، فاستقرّ ، من بعدُ ، أنّ المعرفة لا تتِمّ ، ولا تكتمل إلّا بسياق من التاريخ ، وأن قطعَ الفكر عمّا حوله لا يفضي إلى معرفة صحيحة .
كان القرنُ التاسع عشر قرنَ التاريخ ؛ فلمّا جاء القرن العشرون ، ومضت منه سنوات ، ظهر نمط جديد من الدرس يريد أن ينحّيَ التاريخَ ، ويُبعد عنصرَ الزمان ، ويقفَ على البنية القارّة وحدَها ، وعلى ما تنطوي عليه من مشتبك العلائق . وقد غلا أصحاب هذا الدرس فطووا صفحةَ التارخ كلّها ، واستبعدوا الزمان وما يصنع ؛ ونظروا بمنهجهم هذا إلى اللغة ، وإلى المجتمع ، وإلى الأدب ، وإلى غير ذلك ممّا يقع في إطار المعرفة . وقد أسرف أصحابه ؛ فإمّا أن يكون الدرسُ قائمًا على التبصّر بالبنية وعلائقها وإلّا فلا درسَ ولا معرفة ! ولا ريبَ في أنّ هذا النمط من الدرس قد زاد في المعرفة ، وسلّط ضوءًا على ما كان خفيًّا ؛ غيرَ أنّ ذلك كلّه لا يقتضي الغلوَ والإسراف ، ولا يوجب نفيَ التاريخ ؛ وكان من الحقّ أن تُضاف المعرفة بالبنية إلى ما يُتيحه التاريخ وسياقُه حتّى يكونَ التكامل ، ويقرب ما في الأذهان ممّا في الأعيان .
لقد أدّى إهمال التاريخ إلى نشوء معرفة ناقصة ؛ إذ قُطع ما بين الواقعة وما يُحيط بها فصارت شيئًا معلّقًا في الفضاء لا أصلَ له ولا فرع ! إنّ الحوادثَ ، والأفكار ، والعقائد ؛ لا تُفهم حقّ الفهم من دون مساقها في الزمان والمكان ...!