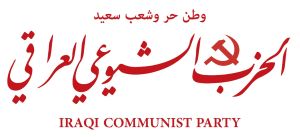في بلد شكسبير وبدعوة من المقهى الثقافي العراقي، قامت أستاذة الأدب الإنكليزي مريم شرارة، التي مارست تدريس لغة وأدب شكسبير لأبناء جلدتها وفي المدارس البريطانية لسنوات طويلة، بتلبية الدعوة لتقدم محاضرتها الموسومة (شكسبير والمسرح) وذلك في مساء الجمعة الرابع من نيسان 2025.
ولأن هذه الأمسية للمقهى (وتسلسلها الثانية والعشرون بعد المائة)، كان من المقرر إقامتها في آذار الماضي، ولكن لتزامن موعدها مع نهاية شهر رمضان وعيد الفطر فقد أقيمت بهذا التاريخ، لكن المقهى لا يفوت عادته بالاحتفاء بيوم المسرح العالمي الذي يصادف في السابع والعشرين من آذار من كل عام، فوجه الدعوة للفنان المسرحي والشاعر العراقي فلاح هاشم ليقرأ في بدء الأمسية الرسالة التي يكلف المعهد الدولي للمسرح التابع لمنظمة اليونسكو في كل عام أحد مبدعي الإخراج المسرحي أو الكتابة المسرحية، ليوجه رسالته بهذا اليوم، وفي هذا العام وقع الاختيار على المخرج والكاتب اليوناني ثيودوروس تيرزوبولوس.. وقرأ الفنان فلاح نصها الذي جاء فيه:
"هل يستطيع المسرح أن يصغي إلى نداء الاستغاثة الذي تطلقه أزمنتنا، في عالم يجد فيه المواطنون أنفسهم مفقرين، محبوسين داخل زنازين الواقع الافتراضي، منغلقين على ذواتهم في عزلة خانقة؟ في عالم يتحول فيه البشر إلى روبوتات، تحت وطأة نظام شمولي يقوم على السيطرة عن طريق الرقابة والقمع، باسطًا ظله على كل جانب من جوانب الحياة؟
هل يكترث المسرح للدمار البيئي، للاحتباس الحراري، للفقدان الهائل للتنوع البيولوجي، لتلوث المحيطات، لذوبان القمم الجليدية، لزيادة حرائق الغابات والظواهر المناخية المتطرفة؟ هل يمكن للمسرح أن يصبح طرفًا فاعلًا في النظام البيئي؟ لقد راقب المسرح تأثير الإنسان على الكوكب لسنوات طويلة لكنه يجد صعوبة في التعامل مع هذه الأزمة".
ويخلص ثيودوروس إلى القول في رسالته:
"إنها أسئلة لا تقبل إجابات نهائية، لأن المسرح يستمر في الوجود بفضل الأسئلة التي تظل بلا إجابة...." أسئلة أثارها ديونيسوس، وهو يعبر مكان مولده، أوركسترا المسرح الإغريقي القديم، ليواصل رحلته الصامتة كلاجئ عبر مشاهد الحروب، اليوم، في اليوم العالمي للمسرح".
وبعد هذه الكلمة المؤثرة عن دور المسرح في الحياة، بقيت أمسية اليوم في أجواء المسرح، فدعا مدير الأمسية المخرج السينمائي والمسرحي (كاتب هذه التغطية)، ضيفة المقهى الأستاذة مريم شرارة، حيث أشار إلى أنه سيتولى مهمته بدلًا من الأستاذة بلقيس شرارة، التي كان من المقرر أن تتولى التقديم، لكن وعكة صحية ألمت بها حالت دون تمكنها من الحضور، فتمنى لها الشفاء العاجل، لكنه قال إنه استلم رسالة من الأستاذة بلقيس إلى الأمسية قرأ نصها التالي وقد كانت بعنوان:
"مريم شرارة شو"
ولدت مريم في جو مليء بالأدب والشعر، فالوالد يتكلم اللغة الفصحى في البيت وكان شاعرًا وأديبًا، وكان يكتب المقالات في الصحف اليومية، وأخيه عبد اللطيف كاتب مهم في لبنان. كانت مريم أول طفلة، وأُعيرت اهتماما كبيرا لأنها أول طفلة.
وكنت أنا في طفولتي أقرب إلى مريم من الأشقاء الآخرين، إذ تركتنا والدتي عندما كنا طفلتين في الابتدائية وسافرت لمدة عام إلى لبنان بسبب تردي صحتها، فتوطدت علاقة خاصة بيني وبين مريم استمرت حتى الآن. وكنا في تلك الفترة نقرأ بنهم الكتب الأدبية خاصة، وكنا ثلاثتنا في سباق في قراءة الكتب.
كما كانت مريم متفوقة في المدرسة على الطالبات والطلبة أثناء دراستها الابتدائية والثانوية ثم الدراسات العليا، وعندما أكملت دراستها في دار المعلمين العالية في بغداد، حصلت على بعثة دراسية إلى إنكلترا عام 1958، فحصلت على درجة BA (بكالوريوس) في الأدب وعلى شهادتين MA(ماجستير)، وتخصصت بالأدب الإنكليزي.
تعرفت في جامعة ليستر على زوجها جيم شو الذي كان يدرس في نفس الجامعة، وبعد تخرجهما سافرا للتدريس في جامعة الخرطوم في السودان، حيث قضيا ستة أعوام.
ثم عادت مريم إلى لندن لتقضي حياتها في التدريس في لندن حتى التقاعد، ولم تزر بغداد إلا بعد الحادثة المؤلمة التي مرت بها عائلتنا في 1997 بفقداننا لشقيقتي حياة وابنتها مها، حيث قضت ثلاثة أشهر لكي تكمل معاملات زينب ابنة حياة لكي يسمح لها بالسفر، عادت إلى لندن وقضت وقتها في التدريس في كلية أكتن في لندن".
بلقيس شرارة*
كاتبة ومتخصصة بالأنثروبولوجيا
وسأل مدير الجلسة إن كان لدى الأستاذة مريم إضافة لورقة الأستاذة بلقيس، شقيقتها، فقالت إنها درست في جامعة هاتفيلد الأدب الإنكليزي وحصلت فيه على ماجستير ثالث، وكان الماجستير الأول في علم التربية والثاني في علم اللغة من جامعة (ريدينغ).. وأضافت أنها ذهبت مع زوجها لوطنها العراق في زيارة ثانية، وعملا فيه لمدة عام. وقالت إنها ألفت مع كاتبتين عراقيتين كتابًا تناول أصول تعلم اللغة العربية للمغتربين لمرحلتي الدراستين المتوسطة والإعدادية البريطانيتين. كما ترجمت كتابًا عن الإنكليزية إلى العربية عن (التربية وعلم النفس) بمشاركة البروفيسور موفق الحمداني.
بعد ترحيبه بضيفة الأمسية الأستاذة شرارة، طرح مدير الأمسية المحاور التي ستتناولها محاضرة اليوم فقال إنه سيأتي عليها بصيغة تساؤلات وهي:
- لماذا كان المسرح مهمًا في عصر شكسبير؟
- ما هي أوجه الاختلاف بين المسرح الذي كان عليه وقت شكسبير والمسرح في الوقت الحاضر؟
- كيف يتشابه تصرف الجمهور في عهد شكسبير مع تصرف المشاهدين في سينما الأعظمية في بغداد؟ وعقب "أن هذا التشبيه من الأستاذة مريم".
- كيف كان أداء الممثلين على الخشبة لأدوارهم المسرحية وما هي الفروق بين أداء زملائهم في وقتنا الحالي؟
- كيف انتقل اهتمام وليم شكسبير في كتابته لنصوصه من التركيز على حبكة النص إلى سبره لأغوار نفسية لشخصياته؟ وما هي عناصر التطور التي طرأت على نصوصه المتأخرة؟
- ما سبب إيلاء شكسبير لدراسة شخصياته بعمق وكشف النقص أو الخلل الرئيسي في تكوينها وسلوكها؟
وقبل أن يعطي الحديث للسيدة المحاضرة، دعا علي رفيق الحضور إلى مشاهدة تقرير قصير متلفز يصور معمار مسرح (غلوب ثياتر – المسرح البيضوي – المسرح العالمي) المسرح الذي شارك وليم شكسبير بتأسيسه والذي أُعيد بناؤه قبل سنوات، ولكن بعيدًا عن موقع المسرح الأصلي، الذي تعرض للحرق أكثر من مرة وهو على الضفة الجنوبية لنهر التايمس الذي يشطر العاصمة البريطانية إلى جانبين. وكان المسرح قد تأسس في عام 1599، ووضح التقرير أن بناء المسرح الذي لم يكن تقليديًا كما نعرفه اليوم بـ (مسرح العلبة) إنما كان فضاءً مفتوحًا وخشبة بدون ستائر ومدرجات الجمهور صُممت بشكل معين لعدة طوابق، السفلى كان يحضرها جمهور من عامة الناس يدفعون (فلسًا واحدًا) ليشاهدوا العروض وقوفًا يجلبون معهم طعامهم ومشروباتهم، تلك الفئة الذين كان يطلق عليهم شكسبير تسمية (الأرضيين)، وكلما ارتفعت الطوابق ارتفعت الأسعار وكان النبلاء وأصحاب الألقاب من الأغنياء يرتادون مقصوراتهم الفخمة، التي حرص المعماري في بنائها أن تبتعد عن روائح الأطعمة والخمور التي كانت تنبعث من الطوابق الدنيا.. وكان الأغنياء لا يعيرون كبير اكتراثهم للعروض بقدر ما كانوا يحضرون ليستعرضوا أزيائهم الأنيقة وتبرج نسائهم وتنافسهن بالأزياء فيما بينهن.
كان التقرير التلفزيوني قد انطوى على معلومات جيدة نقلت حضور الأمسية إلى التمثيل والأداء يومذاك وأشار إلى أن الأدوار النسائية للشخصيات المسرحية كان يؤديها الرجال، لعدم قبول المجتمع مشاركة المرأة بالتمثيل، فكان يتم اختيار رجال أجسامهم رقيقة وأصواتهم ناعمة ويرتدون أزياء نسائية ويعملون مكياجًا متقنًا يخفي أشكالهم الذكورية.
"سأبدأ بالكلام عن المسرح..." بهذه العبارة استهلت الأستاذة مريم شرارة محاضرتها وقالت إن المسارح في زمن شكسبير كانت بأربعة أنواع: الأول المسرح الخاص بالبلاط والنبلاء والأرستقراطيين، والثاني على عكس الأول إذ كان مخصصًا للعامة وكان موقعه في الحانات التي تُفرد باحة من موقعها للعروض، وكان صاحب الحانة يشجع الممثلين الذين يدفعون له إضافة إلى تشجيع الزبائن لارتياد حانته، والنوع الثالث هو المسارح المتنقلة التي تجول المدن والأرياف وكان من يمثل فيها من غير المحترفين، وهي كانت تؤدي دورها في تلبية رغبة سكان المناطق المختلفة الذين كان يتعذر عليهم السفر إلى لندن لمشاهدة الأعمال المسرحية.. أما النوع الرابع فكان مسرحًا خاصًا، صغير الحجم، يشبه الـ "غلوب". ثم انتقلت الأستاذة شرارة إلى الحديث عن طبيعة مشاهدي المسرح يومذاك، فذكرت أن: المجتمع في عهد شكسبير كان طبقيًا، كان ملك البلاد فيه يمثل الإله على الأرض ويليه في المكانة النبلاء والأرستقراطيين، وكان للكنيسة الأثر الكبير في المجتمع وكانت تفرض على الجميع حضور قداس يوم الأحد، وهناك طبقة المثقفين وهم خريجو الجامعات والذين يتوفرون على معرفة العلوم والآداب، ودرسوا البلاغة والخطابة وعلوم اللغة.. وهم يعتبرون من النخبة وهؤلاء كانوا يتمتعون بمشاهدة مسرحيات شكسبير، لأنه كان يكتبها بلغة عالية ولأنه كان يستخدم الأساطير الرومانية وحكايات الكتاب المقدس.. كل هذه الطبقات كانت ترتاد المسرح إضافة إلى الفقراء وكذلك حثالة المجتمع أمثال اللصوص والنشالين والعاهرات وحتى المجرمين". وعزت المحاضرة حضور هؤلاء إلى أن "شكسبير كان يكتب مسرحياته لكل الطبقات، فمثلًا المشاهد التي كانت تغري الأميين هي معارك الصراع بين الأبطال والمبارزات بالسيوف، ومشاهد المهرجانات الموسيقية والراقصة، إضافة إلى مشاهد السحر والخرافات، التي كان الكثير يؤمن بها، وشكسبير كثيرًا ما استخدمها في أعماله وكان هؤلاء يحبون العنف بصورة عامة". وهنا أشارت الأستاذة إلى أن المقهى الثقافي قدم في العام الماضي أمسية كرست عن العنف في المسرح الشكسبيري.. وأشارت أيضًا إلى ممارستهم لسلوكهم غير المهذب حيث لم تكن غايتهم الإصغاء للمشاهد الجادة، فكانوا يأكلون (الكرزات) ويضربون الممثلين بالطماطم والبيض ويشربون البيرة والكحول، حيث بعدها تبدأ المشاكل ويعلو الهرج والمرج، وهنا قالت الأستاذة شرارة: "هذا ما ذكرني بجمهور مشاهدي سينما الأعظمية في بغداد إذ كانوا يأكلون (الكرزات) وقشورها تغطي أرضية صالة العرض أو مثلًا يدخل أحدهم ينادي صاحبه قائلًا: أحمد العشا حاضر". وأكدت على أن الكنيسة عملت على توعية الناس.
ثم تحدثت المحاضرة عن الأداء التمثيلي في ذلك الحين فقالت إن ممثلي المسارح المتنقلة كانوا غير محترفين يشخصون أدوارهم بشكل سيئ.. لكن ممثلي المسارح الثابتة كانوا أكثر إتقانًا لأدائهم.. وخاصة عندما وصل شكسبير إلى لندن في العام 1592 وساهم في كتابته بتطوير مهارة الممثلين وكان يكتب شخصيات يخصصها لممثلين بعينهم، وهو يعتمد على الأداء الخطابي والمبالغة بالتمثيل والإلقاء، وأن العروض كانت تقام بالنهار لانعدام الإنارة مساءً.
وفي محور النتاجات المسرحية لشكسبير، ذكرت أنه كتب 37 عملًا مسرحيًا في حياته، أي بمعدل مسرحيتين في العام الواحد، وهذا معدل يعتبر عاليًا.. وكتب مجموعة أشعار (فينوس وأدونيس) وكتب السوناتات وهي قصائد قصيرة تتكون من أربعة عشر بيتًا.. وأعماله المسرحية تُقسم إلى ثلاثة أنواع، منها ست عشرة مسرحية كوميدية ورومانسية، وعشر مسرحيات تاريخية تناولت التاريخين البريطاني والروماني، أما المسرحيات التراجيدية (المأساوية) فقد كتب إحدى عشرة مسرحية وقالت: "إن مسرحية (روميو وجولييت) كتبها شكسبير في بداية حياته، واعتبرها بمثابة مختبر تجريبي بالكتابة، وركز فيها على الحبكة، والحوادث هي التي تسيطر على البناء الدرامي وليست الشخصيات". وسردت مثالًا على ذلك مشهد المقبرة حيث إن جولييت تصنعت الانتحار وحين رآها روميو كذلك تجرع السم حزنًا عليها، وعندما أفاقت وعرفت بما فعل صارت تلثم شفاهه بالقبل سعيًا من أن يفعل السم وينهي حياتها، ولما وجدت أن ذلك لم يُجدِ نفعًا بموتها تستل خنجر حبيبها وتطعن نفسها منتحرة. واعتبرت هذا المثال دليلًا على اهتمام شكسبير بالحبكة وتسلسل الأحداث.. لكنها أشارت إلى أن في مسرحياته المتأخرة صار يهتم ببناء شخصياته وعمل على إيجاد خلل أو نقص في سلوكها، فعند مكبث والليدي مكبث الطموح غير المشروع واقترافهما جريمة القتل للصعود للعرش وعند عطيل الغيرة العميقة التي تقوده إلى اقتراف القتل أيضًا، لكن هذه الشخصيات تتصارع مع نفسها فتندم على ما فعلت واستنتجت المحاضرة أن اختراق شكسبير لبواطن شخوصه هو نوع من (حداثة) في الكتابة المسرحية.. واستخدامه للعقل الواعي واختراقه للعقل غير الواعي (مثال مشهد كابوس ريتشارد الثالث بمجيء كل ضحاياه الذين قتلهم) وقالت إن شكسبير بهذا المشهد جاء بهذه الفكرة قبل أربعمئة سنة مما طرحه فرويد لاحقًا في (تفسير الأحلام).
وفككت المحاضرة عدة مشاهد من مسرحيات شكسبير وقرأت بعض حواراتها لتبرهن على أسلوب شكسبير في صياغته لأحداث مسرحياته واهتمامه باللغة وتعمقه في سبر أعماق شخصياته وتحدثت عن المصادر التي استقى منها موضوعاته.
بعد الرحلة الشيقة التي أخذتنا معها الأستاذة مريم شرارة جاء دور الأسئلة والمداخلات من حضور الأمسية:
- عبد المنعم الأعسم (كاتب وصحفي): الدراسات عن مسرح شكسبير كثيرة، وهناك من يعتبر أن نتاجه أدبًا تقدميًا بمعنى أنه يشكل احتجاجًا مجتمعيًا ضد النظام الإقطاعي المتحالف مع الكنيسة.. ومن هنا تعامل معه العديد من الباحثين والمسرحيين من هذا المنطلق كأدب احتجاجي.. في حين اعتبره بعض آخر أدبًا يمثل الإقطاع.. فهل هذا يتوقف على المخرج أو الكاتب في تصنيف الأدب الشكسبيري؟ -كانت إجابة الأستاذة مريم أن من عظمة شكسبير تكمن في أن كتاباته يمكن تأويلها إلى عدة تأويلات، صحيح أنه كتب عن الملوك والنبلاء، لكنه كان يؤكد في كتاباته على أن يتحلى الحاكم بصفتين هما العدل والرحمة.
- وعلق علي رفيق عن تجارب مسرحية عراقية فسرت أو أولت شكسبير وأورد عدة أمثلة منها (هاملت عربيًا) من إخراج سامي عبد الحميد وإخراج حميد محمد جواد لهاملت وحذفه للشبح وإخراج مناضل داود لـ (روميو وجولييت في بغداد) وجعل العائلتين المتخاصمتين إحداهما سنية والأخرى شيعية.
- فلاح هاشم (مسرحي وشاعر وإذاعي): كانت مداخلته عما ذكرته المحاضرة من خلل الشخصية المسرحية واستشهد بالكاتب برادلي الذي يسمي هذه الخاصية بـ (الميزة الدرامية) وهي التي تقود سلوك الشخصية وتؤدي إلى النهاية، وهذه على الأخص في أعمال شكسبير التراجيدية، مثالًا على ذلك ميزة عطيل الدرامية هي (الغيرة) ومكبث (الطموح) وهاملت (التردد والشك) وروميو (الطيش).. أما غرض شكسبير وهدفه فهو مفتوح على التأويل.. ولاحظ الفنان هاشم أن أداء الفنانين الروس للأعمال الشكسبيرية سواء في المسرح أو السينما أو الباليه بجودة فاقت حتى الإنكليز.
- رضا الظاهر (كاتب وصحفي ومترجم): أشار إلى أن ما قدمته الأستاذة شرارة إضاءات هامة وبعضها مثير للجدل.. وطرح ثلاث ملاحظات هي: التراث الذي قدمه شكسبير لا بد أن يكون وراءه عقل أسماه عقل التنوير واعتبره أحد أهم أسلاف حركة التنوير التي ظهرت في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، وأنه كان نصيرًا للنساء وخاصة في رسمه لشخصياته الإيجابية مثل جولييت وديزدمونة وأوفيليا. وثانيًا أنه عاش في فترة يمكن وصفها بفترة الانتقال من مرحلة الإقطاعية إلى المرحلة الرأسمالية ويتجلى هذا في مسرحيتي (تاجر البندقية) و (العاصفة)، في الأولى اعتبر (شايلوك) هو الناطق الرسمي للرأسمالية في بداية تشكلها. أما الملاحظة الثالثة فهي موضوعة السلطة وهذه موجودة في أغلب مسرحياته حيث يتجلى الصراع الاجتماعي.
- عقبت الأستاذة شرارة أنها اختصرت محاضرتها بسبب ضيق وقت الأمسية ومن بين ما حذفَتْهُ هو سيرة شكسبير وفيها شخصت المرحلة الإقطاعية لأن أغلب الناس كانوا من الفلاحين وحتى أقنان وأشارت إلى أن والد شكسبير يمثل الطبقة الجديدة من التجار وكان يستورد الأصواف التي تدخل في صناعة النسيج. ـ أخيرًا أشارت السيدة بدور الددة (حقوقية وروائية) إلى أن ما يشاع أن الملهم لشكسبير كان الدوق ساوثهامبتون.. والإشاعة تذهب بعيدًا فتقول بل إن ذلك الدوق هو الذي كان يكتب الأشعار وشكسبير ينشرها باسمه، فقد كان في ذلك الوقت من غير المحبذ أن يكتب النبلاء مثل هذه الأشياء.. وتساءلت عن مدى صحة ذلك؟
- فأجابت الأستاذة مريم بالقول: هناك البعض وخاصة نقاد أمريكيون يقولون إن شكسبير لم يكن مثقفًا ولذا ليس هو من كتب المسرحيات.. إن هذه أقاويل عارية عن الصحة.. وفي سيرة شكسبير أنه درس في مدينته ستراتفورد آبون آفون وكان قد اطلع على مصادره من الآداب اللاتينية والإسبانية والإيطالية والفرنسية والتي كانت جميعها مترجمة إلى الإنكليزية.. وكان من يشيع تلك الأقاويل كاتب معاصر له هو بن جونسون غيرة منه ولأن مسرحيات شكسبير كانت تحظى بجمهور أوسع من مسرحياته.
 |
 |